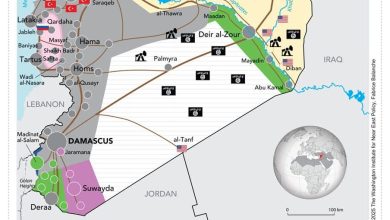حلمي موسى* – غزة

الشيء بالشيء يذكر. كثر الحديث مؤخرا عن نكبة جديدة. تحدث كثيرون عن ان الاحتلال يرمي إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء او طردهم من غزة. والواقع ان الاحتلال حاول على مدى تاريخه السياسي والعسكري طرد السكان من غزة. الكل يتذكر المشروع الأميركي الاسرائيلي في الخمسينات لتوطين الفلسطينيين في سيناء. وربما ان البعض يعرف عن مخطط الاحتلال بعد عام ١٩٦٧ لافراغ القطاع من ساكنيه او على الاقل من جزء كبير منهم، بتسهيل هجرته إلى أمريكا اللاتينية او إلى الضفة الغربية.
وكان الاحتلال قد أدرك ان مساعيه لافراغ القطاع باءت بالفشل على الرغم الأموال الكثيرة التي رصدت والدعم الدبلوماسي من دول كثيرة لتسهيل الهجرة. ومع ازدياد المقاومة وتعاظم الخطر الديموغرافي من غزة اكثر من سواها قرر الانسحاب من طرف واحد. وكان واضحا ان مطمعه في غزة يواجه مصاعب شتى. وصار قادة الكيان يتحدثون ،سواء بعد اتفاق أوسلو او بعد الانسحاب عن ان الخروج من غزة يعني الإبتعاد عن مشاكلها وواقعها المؤلم. فثلثا سكان غزة هم من اللاجئين من فلسطين المغتصبة، وأكثرهم اصلا من سكان لواء غزة. ومعروف ان قطاع غزة المعروف حاليا بهذا الاسم لم يكن يقطنه قبل النكبة اكثر من ١٠٠ الف نسمة، وقد جلبت له النكبة ٢٠٠ الف اخرين تقريبا. ومعروف ان سكان القطاع حتى العام ١٩٦٧ لم يكونوا اكثر كثيرا من ٣٥٠ الفا.
واليوم يطلب الاحتلال من حوالي مليون و٤٠٠ الف مغادرة غزة وجمالها إلى جنوب القطاع. وهذا عدد يزيد اضعافا كثيرة عن اعداد من هجروا من مدنهم وقراهم إلى غزة في عام النكبة. ولذلك يحذر كثيرون من النكبة الجديدة. ومعروف انه مثلما خرجت تظاهرات في الخمسينات ضد مشروع التوطين وسقط فيها شهداء، تخرج اليوم تظاهرات في مخيمات شمال القطاع واحيائه ترفض التهجير الجديد.
ولا ريب ان الفارق هائل بين الفلسطيني في غزة الآن والفلسطيني الذي كان في غزة او هاجر اليها عام ١٩٤٨. الفلسطيني اليوم صاحب تجربة اكبر لجوء في التاريخ منذ ٧٥ سنة ويعي واجب ألا تتكرر النكبة. والفلسطيني الان اشد وعيا، ليس فقط من الناحية التعليمية والثقافية والسياسية من اهله في العام ١٩٤٨، وإنما ايضا ،وهذا مهم، اشد ادراكا للواقع العربي الرسمي على الاقل. وربما لا شيء اشد ايلاما على الفلسطيني من سماع أخوة له عن جهل او عن غرض يتهمونه بأنه باع أرضه.
هجرة أهلي من أسدود
ويحضرني في حالي هذا واقع ما جرى لعائلتي قبل أن أولد. فقد كان والدي شيخا ازهريا وتاجرا ويدير مطحنة قمح لبلدة “أسدود” وجوارها. وما سمعته من أهلى انه بعد وصول الجيش المصري إلى اسدود ،وهي ابعد نقطة وصل اليها شمالا، تزايدت الهجمات الصهيونية على البلدة. وكانت قد بدأت عمليات طرد السكان من القرى شمال اسدود وشرقها وصار ضغط يتجمع في أسدود. ومع تزايد الضغط اضطر جزء من الاهالي للرحيل إلى بلدة “المجدل” المجاورة. و من بين من رحلوا في تلك المرحلة جدتي وعمي وزوجته. وبقي والدي ووالدتي واخواي الكبيران واختى الكبرى في اسدود. وسمعت ان بيت والدي تحول الى ملجأ لبعض القادمين من يبنا وبرقة وبيت دراس. ومع اشتداد الضغط هاجر كثيرون وبقي والدي وعائلته في البيت إلى أن سيطرت قوات الهاغاناه على اسدود بكاملها. وبقي والداي والعائلة وقتا ربما لإسبوع او اكثر في بيتهم رغم الاحتلال.
ولكن بعد ذلك في صبيحة يوم هادئ طلب المحتلون من سكان البلدة الباقين في بيوتهم التجمع وسط القرية. وبعدها جرى تصنيفهم وتم أسر الشباب بينهم ومنهم اخي الأكبر الذي ربما كان في السادسة عشرة من عمره. نقلوا الاسرى او من بقي منهم على قيد الحياة إلى معسكر عتليت قرب حيفا. وقامت شاحنات وباصات بالقاء باقي السكان على حدود المجدل حيث لم تكن محتلة وقتها.
هنا بدأت رحلة النكبة لعائلتي حيث التقى والدي بأخيه وأمه في المجدل واتجهوا بعدها الى غزة. وهذه قصة تشبه قصص عشرات الألوف او مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين، ليس في غزة وإنما في كل مكان وصله اللاجئون.
وكانت غزة أرضا جرداء وفقيرة رغم أنها ارض عز وكرامة وكرم. ووجد اهلي ملاذا في بيت عائلة قطيفان في الشجاعية. وربما انه بسبب وضع والدي المرتاح نسبيا من الناحية المادية لم يتشرد أهلى في الشوارع والبساتين. وظلوا في مدينة غزة. لكن مع مرور الوقت وازدياد الحاجة اضطر والدي ليذهب مع عم اخر لي ومع ابنه الذي كان في الثانية عشرة من عمره للتسلل خلسة إلى اسدود في مغامرة حياة او موت، لجلب بعض المخزون من القمح والبحث عن مال كان اخفاه وقت احتلال البلدة.
باختصار كانت الحياة في السنة الأولى للجوء ضنكا وظروفا غير انسانية إلى حد بعيد. ولاحق القتل اللاجئين حتى في داخل غزة، ما اضطر كثير من اللاجئين إلى مواصلة المسير واختراق الحدود المصرية حتى القنطرة على قناة السويس. هناك جرى في البداية تجميع اللاجئين في معسكر اولي، ولكن ما ان تزايد عددهم حتى قامت مصر بارجاعهم إلى حدود رفح. وهذا يفسر ان معسكر رفح كان اكبر معسكرات اللاجئين في القطاع حتى العام ١٩٦٧.
كتبت كل هذا الكلام كي افسر سبب انطلاق التظاهرات في غزة رفضا للتهجير وتنديدا بالنكبة الثانية. والقول السائد بين الناس “نموت في ارضنا ولا المذلة في اي مكان أخر”. وهذا حال الفلسطيني في غزة الان.

أنا وابنتي “تمار”
اكثر ما ادهشني في هذه الحرب مقارنة بحروب سابقة كثرة من افصحوا عن مشاعر المحبة لي. وطبعا كل واحد بطريقته. وبعض من افصحوا عن هذه المحبة أناس يعرفونني جيدا وتجمعني بهم صداقة عميقة. آخرون جمعتني بهم الحياة في ظروف مختلفة، وكنت أشعر بتقديرهم لي ويشعرون بمحبتي لهم. لكن ما فاجأني ربما اكثر من اي شيء آخر مقدار الحب الذي تكنه لي إبنتي “تمار” .
والواقع ان ابنتي لم تعش معي كثيرا، ولم أكن جوهريا بين من اثّروا في حياتها عمليا. كانت في التربية ابنة امها اكثر من ابنة ابيها. كانت امها تغار وهي طفلة من الشبه الكبير بينها وبيني. وربما بعد أن كبرت البنت واختارت طريقها بعيدا عني صارت هي وامها تشعران كم انها تسلك فعليا طريقي. وكنت احتار احيانا في مقدار التناقض الذي يبدو بيننا.
في ٤ يوليو تموز حضرت “تمار” للمرة الأولى في حياتها وهي واعية إلى غزة. كانت قد حضرت وهي طفلة في عامها الأول سنة ١٩٩٢ إلى غزة. وكنت خائفا جدا من التناقض الذي يمكن أن تصطدم بها صبية متحررة تعيش في نيويورك في واقع محافظ جدا ،هو واقع أهلها واقاربها. كنت متخوفا شديد الخوف من زيارتها ،وكنت في قرارة نفسي افكر بأن من الأفضل أن تتأجل قدر الإمكان.
وشاءت الاقدار ووصلت هي ووالدتها ،فكان أن سحرتها حمية غزة وكرم أبنائها وشدة عاطفتهم ،وكانت تأتيني باكية لأنها لا تستطيع تحمّل هذا القدر من الحلاوة والحب الذي تحاط به من أقرباء واصدقاء . وطبعا كانت طوال الوقت تستغرب كل هذا القدر من المحافظة والتردد الاجتماعي. وقد تغير موقفها بعض الشيء مع مرور الوقت.
لكن اشد ما تغير هو كيفية افصاحها عن حبها لي. صارت تردد انها بحاجة لان تكون معي وقتا أطول. وانها بحاجة لأن تدير معي نقاشات وطنية واجتماعية وسياسة وعائلية. وكنت قدر امكاني اضبط نفسي واسايرها بلطف ومحبة. وبعد أن تركت غزة كانت تبكي لأنها لم تكن تعرف هذا الحجم من الحب الذي في نفوس الناس هنا. ولأنها متكتمة بعض الشيء في سلوكها العام لم تنطلق كثيرا في الإفصاح عن حبها.
امس انهار سد أمامها وقالت لي بنوع من الحزن إنني كل عالمها ،وإنني كنت على الدوام المحفّز لها على فعل كل ما فعلته في حياتها. وهي الآن تنهي دراسة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نيويورك، ومن نشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية الشبابية في الولايات المتحدة.
كنت امازحها ،وكثيرا ما أمازح أصدقائي عندما يسألونني لماذا يحبونني، فأقول لأنهم لا يعرفونني على حقيقتي.
والحقيقة انني على الدوام ما كرهت أحدا ،الا عندما أشعر بكراهيته للآخرين ،واحب كل الناس الطيبين ولم ادخر جهدا في مساعدة كل من قدرت على مساعدته. هذه هي الطينة التي جبلنا فيها في مخيمات اللجوء في بيوت بسيطة علمتنا أن لا شيء في الحياة اغلى من كرامة الانسان.
*هذه خواطر كتبها الصديق والزميل الصحافي حلمي موسى خلال الأيام الماضية في غزة وأرسلها لي ،فاستأذنته بنشرها في الحوار نيوز (واصف عواضة)