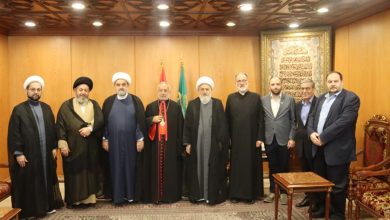منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفترة توسيع النظام النيوليبرالي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، لتطويق العالم، قامت الولايات المتحدة بإعادة مضاعفة جهودها لتحويل معاني المفاهيم السياسية الأساسية التي يستخدمها اليسار العالمي في مواجهة الهيمنة الأميركية.
وتحقق الهدف المتمثل بإعادة تشكيل تامّة للثقافة السياسية العالمية، داخل الولايات المتحدة، لكنه لم ينجح كثيرًا خارجها. ورغم أن هذا المشروع قد أحدث تحولات كبيرة داخل الولايات المتحدة منذ فجر الحرب الباردة في أواخر الأربعينيات، إلا أنه لم يعُد سوى بآثار هامشية على الشعوب الأخرى بخلاف الجماهير الأميركية مغسولة الدماغ (باستثناء بريطانيا وألمانيا، وفرنسا إلى حد أقل).
وهدف مشروع الثمانينيات إلى تكثيف هذه الجهود على مستوى عالمي، خصوصًا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. واتّبع هذا التحوّل استراتيجيتين.
عصر اللغة المضللة
انطوت الاستراتيجية الأولى، على إفراغ المفاهيم من خصوصياتها ومعانيها النظرية، من أجل سلخها عن ارتباطها بالقوة الأميركية، ومن ثم التوجه لتطبيقها عالميًا. وهنا تتجسد "اللغة المضللة" التي اقترحها الكاتب، جورج أورويل، في روايته الشهيرة "1984".
ولنأخذ المفهوم الماركسي للإمبريالية، المرتبط مركزيًا بالدول الرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر، في سعيها الربحي لاستخراج موارد الدول الأخرى بينما تهيمن عليها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مثلا لذلك.
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أقر بعض المثقفين القوميين الأميركيين، بأن دولتهم قد تكون إمبريالية بالفعل، لكنهم استمروا في تطبيق هذا المفهوم على الاتحاد السوفييتي أولًا، والذي كان ريغان، يصفه بـ"الإمبراطورية الشريرة"، شأنه شأن المنظّر نوعام تشومسكي.
وعبر الإرباك المتعمد في الإشارة إلى أي هيمنة دولة ما على دول أخرى، بأنها فعل "إمبريالي"، بدأت الولايات المتحدة مؤخرًا في توجيه تهمة الإمبريالية إلى روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، والصين وحتى إيران.
ولكن بعض الأكاديميين يشعرون بالقلق إزاء التحوّل الطارئ على اللغة السياسية الذي أرساه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، فقط، فعلى ما يبدو، لا يعلم هؤلاء عن المشروع التحويلي الأكبر في الولايات المتحدة الجاري منذ الأربعينيات.
خلال العصر السوفييتي، حظي جميع حلفاء الاتحاد السوفييتي في أوروبا الشرقية، بدخل مساو للفرد مع السوفيتيين، أو أعلى في بعض الحالات، كما أن هذه الدول، حصلت أيضًا، وفي كثير من الأحيان، على دعم حكومي من السوفييتيين الذين استوردوا سلعهم الصناعية وصدروا المواد الخام إليهم في توجه مناقض للنمط الإمبريالي، لكن هذه الحقيقة بدت غير ذات صلة، بالنسبة لهذه الاتهامات الصبيانية (بأن الاتحاد السوفييتي "إمبريالي").
وإذا شهدت البلدان الواقعة تحت قيد الإمبريالية الأميركية، والتي يعادل دخل الفرد فيها فتاتًا بالمقارنة مع نظيره الأميركي، ارتفاعًا بالمدخولات إلى مستوى متماثل مع الدخل في الولايات المتحدة، أو أعلى منه، عندها يمكن أن يتحدث المرء عن تكافؤ بين "الإمبريالية السوفيتية" المزعومة والإمبريالية الأميركية الحقيقية حول العالم. ولا تساهم أمثلة ارتفاع دخل الفرد للمواطنين في بضعة دول كالكويت أو سنغافورة، في إثبات عكس ذلك (ناهيك عن أن هذين المثالين يتجاهلان العدد الهائل للعمال الأجانب في كلا البلدين الذين يقل دخلهم بدرجة كبيرة عن المواطنين).
تعريف الديمقراطية
تُعد "الديمقراطية"، مفهومًا يساريًا مركزيًا آخر، استُخدم منذ الثورة الفرنسية. وتتحدث الولايات المتحدة ومثقفوها القوميون بلا خجل عن كون الولايات المتحدة دولة ديمقراطية منذ عام 1776. وعلى ما يبدو، فإن قرنين من السرقة الاستعمارية والإبادة الجماعية الجسدية والثقافية ضد الأميركيين الأصليين، وقرن من العبودية أعقبه قرن من الفصل العنصري، وقرن ونصف القرن من حرمان المرأة من حقها في التصويت، لا صلة له بهذا التعريف.
وفي حين أن الولايات المتحدة كانت في الواقع، ديمقراطية للسيد الأبيض الذكر، في تلك الفترة، فليس هذا هو ما تعنيه كلمة "ديمقراطية" لبقية العالم، ناهيك عن بقية الشعب الأميركي المُستثنى من "الديمقراطية" المزعومة.
صحيح أنه في الفترة الممتدة ما بين عامي 1965 و2001، يمكن للمرء أن يصف الولايات المتحدة بأنها "ديمقراطية" قمعية وعنصرية ومنحازة جندريًا، باعتدال، لكنها تراجعت منذ انتهاء تلك الفترة إلى "ديمقراطية" قمعية للغاية، وعنصرية.
ومع ذلك، فإن قوة القومية الأميركية المتطرفة، بلغت حد أن الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة خارجيته السابقة، هيلاري كلينتون، يتحدثان بكل فخر عن "الآباء المؤسسين" (للولايات المتحدة)، وفكرة "أننا أقدم ديمقراطية في العالم"، وهي تلك الديمقراطية التي أقصت كليهما بحكم الواقع. وهذا يتماثل مع أن يتحدث الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، مثلا، عن مؤسسوها العنصريون، على أنهم مؤسسي ديمقراطية بلاده، والتي "تطورت" لشمل السود بعد عام 1994 فقط.
إن استمرار خطاب الولايات المتحدة والقوة الأوروبية، تمثيل الأوروبيين البيض والأميركيين من أصول أوروبية، الذين قتلوا عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، واستعبدوا عشرات ملايين آخرين ومارسوا ضدهم أشد أشكال الوحشية للتعذيب، على أنهم "متحضرون"، وإضفاء وصف "الهمجية" على السكان المستعبدين والخاضعين في العالم، والذين يناضلون من أجل التحرير، جزء لا يتجزأ من المشروع الأميركي الجاري.
إدانة العنصرية
وبالطبع، فقد خضعت حتى مصطلحات أخرى، مثل العنصرية، التي ترتبط بالسلطة السياسية والاقتصادية لأوروبا الغربية والولايات المتحدة، شأنها شأن الإمبريالية، لإفراغها من معانيها، وطُبقت كونيًا. وفجأة أصبح كل من هو غير أبيض، ويحمل أفكارًا ضارة للأوروبيين والأميركيين البيض، يُعرف على أنه "عنصري".
لكن فكرة عنصرية أوروبا والولايات المتحدة، البيضاء، لا تتعلق فقط بثقافات هذه المجتمعات المؤذية بشكل مرعب، وعنصري وواسع النطاق، بل بأن هذا التحيز كان دائم الرسوخ في مؤسساتها السياسية والاقتصادية للسلطة، أي في المؤسسات التي تحرم الناس من المساواة في الحقوق على أساس التحيز العنصري، بما في ذلك الحق في العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، والتي تميز ضدهم في القانون، وتعرضهم لقمع الشرطة، إلخ.
وما من دولة غير بيضاء، أو شعب غير أبيض، تحظى بالقدرة على قمع البيض كمجموعة، حتى وإن نظرت إليهم بعين الأذى. وعلى الرغم من أن إدانة العنصرية كانت دائما تتعلق أساسا بمؤسسات السلطة، فإن المعنى الإمبريالي والنيوليبرالي الجديد للعنصرية قد حوّلها إلى مجرد تحيز شخصي.
وفي الواقع، منذ ثمانينيات القرن العشرين، بدأ بعض المثقفين العرب والإسرائيليين والغربيين (بمن فيهم صادق جلال العظم، وفواز طرابلسي، وأفيشاي مارغاليت، وإيان بوروما، من بين آخرين) يتحدثون عن "الاستغراب" باعتباره عكس "الاستشراق"، كما لو أن هناك دولة عربية واحدة تملك مؤسسات قوية مملوءة بكراهية الغرب، وتستخدمها لقمع جميع الأوروبيين، بنفس الطريقة التي قامت بها الإمبريالية الأوروبية بإضفاء الطابع المؤسساتي على الاستشراق من خلال سياساتها الاستعمارية والإمبريالية في المشرق المستعمر.
ويفترض هؤلاء المثقفون في وضعهم "الاستغراب" مؤشرًا للعدائية ضد الغربيين، أن الاستشراق ليس شيئًا راسخًا في المؤسسات الإمبريالية القوية التي حللها إدوارد سعيد في كتابه الكلاسيكي ("الاستشراق")، بل بأنه عبارة عن مجرد تحيز فردي أو حتى جماعي، لا علاقة له بالسلطة على الإطلاق.
وكالة المتعاونين
كانت استراتيجية الولايات المتحدة الثانية، هي تحويل مفاهيم يسارية سابقًا، استُخدمت لإدانة سياساتها، إلى مُضاد لليسار ذاته، عبر الاستئثار بها كمبادئ أميركية رسمية. وهذه تتضمن الدعم لـ"المجتمع المدني" و"النشاط" السياسي في بلدان العالم الثالث، ومؤازرة "وكالة" الأقليات العرقية والنساء داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتفضيل "الثورات" والحكومات "الشرعية" على "الاحتلال الأجنبي"، ما لم تكن القوات العسكرية الأميركية أو الإسرائيلية هي التي تقوم بهذا الاحتلال.
ومنذ الثمانينيات، تحولت آلاف المؤسسات غير الحكومية الممولة أميركيا وأوروبيا، والخاضعة للأجندات السياسية التي يتبانها مموليها، إلى "مجتمعات مدنية" محلية، ويُصور موظفوها الذين يحصلون على رواتب مرتفعة على أنهم مجرد "ناشطين".
بالإضافة إلى ذلك، بدأ الحديث عن نشر "وكالة" للمضطهدين، من أجل الدفاع عن أولئك الذين يتبنون الأفكار الإمبريالية والعنصرية ضد شعوبهم، والذين تختارهم الولايات المتحدة متحدثين باسم هذه الشعوب.
إذا، فمن ناحية، تتمثل إدانة الداعية المناهض للعرب، والمناصر للإمبريالية، فؤاد العجمي، بحرمانه من وكالته، وتمامًا كما ستُعد مهاجمة قاضي المحكمة العليا الأميركية، الأسود، كلارنس توماس، بسبب آرائه النيوليبرالية والعنصرية وقراراته القانونية بمثابة حرمان من وكالته أيضًا، وهلم جرا.
ومن الناحية الأخرى، فإنه بالنسبة للكثيرين من عاملي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول العالم الثالث، الذين يُنظر إليهم بشكل خاطئ على أنهم "ناشطون"، فلا تُنسب الوكالة إلّا لأولئك الذين يدعون مقاومة المؤسسات المحلية والسلطة السياسية بينما يحصلون على دعم لمساعيهم من قبل المنظمات غير الحكومية الغربية. إن اتهام أولئك الذين يتعاونون مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومي، الإمبريالية، بالتواطؤ والتعاون مع الإمبريالية سيكون كـ"حرمانهم" من وكالتهم، في الوقت الذي يكون فيه في الواقع، اعترافا بوكالتهم كمتعاونين.
في الوقت نفسه، تُرفض وكالة أولئك الذين يقاومون الإمبريالية الأميركية في بلدانهم بشكل روتيني من قبل "ناشطي" المنظمات غير الحكومية، الذين يرفضونهم باعتبارهم مجرد "وكلاء" لـ"إمبريالية" روسية أو صينية أو إيرانية مزعومة.
خطاب "الشرعية"
في الصحافة العربية والإعلام المتلفز، المملوكة حصريًا تقريبًا لنظام أو لأمير خليجي، أصبح هذا الخطاب الفعّال. إن استجواب معاني الهيمنة الجديدة، يفتح السائل أمام جميع أنواع الاتهامات، خاصة من قبل مجندي وسائل التواصل الاجتماعي للثقافة الإمبريالية الجديدة.
وبالنسبة لخطاب "الشرعية"، نجد مثلًا، أن قادة انقلاب فتح في السلطة الفلسطينية الذين استولوا في عام 2007 على الضفة الغربية وطردوا حماس المنتخبة من الحكومة ليكونوا الحزب "الشرعي"، بينما تُصور حماس، التي حافظت حكومتها المنتخبة في غزة ضد قادة الانقلاب غير الشرعي، على أنها الطرف الذي "انتزع" غزة من السلطة الشرعية للسلطة الفلسطينية.
وفي فنزويلا، أصبح خوان غايدو القائد الشرعي للبلاد، في حين أن الزعماء المنتخبين الفعليين أصبحوا "غير شرعيين"، وأصبح الرئيس البوليفي المنتخب، إيفو موراليس، غير شرعي، في حين اعتُبر قادة الانقلاب المدعومين من الولايات المتحدة والذين أطاحوا به من السلطة، شرعيين.
تتضمن استراتيجية تحويل معاني المفاهيم السياسية كلمات مثل "الثورة" التي تنسب إلى أي مظاهرات جماهيرية ضد حكومة تكرهها الولايات المتحدة؛ و"الإرهاب"، يصف جميع أعمال المسلمين التي تستهدف المصالح الأميركية، سواء كانت عسكرية أو مدنية، ولكن ليس عندما يرتكبها البيض؛ و"الأيديولوجية"، حيث يُعد كل من ينتقد السياسة الإمبريالية الأميركية والغربية شخصا "مؤدلجًا"، في حين أن الذين يدعمونها "موضوعيون" و"براغماتيون" و"معتدلون".
يمكن قياس نجاح هذا المشروع الأميركي بعدد المثقفين المرتدّين، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، الذين يستخدمون الآن المعاني التي تفرضها الولايات المتحدة ويصرون على وصف أنفسهم بأنهم "يساريون". وربما يكون مصطلح "اليسار"، في الواقع، أكثر ما مر بتحولات.
وأصبحت كلمة "يساري" تصف كل من يتبنوا المعاني الأميركية الجديدة لهذه المجموعة القديمة من المفردات اليسارية، في حين يُتهم أولئك الذين ما زالوا يصرون على فضح هذا المشروع الثقافي الأميركي الغادر، بـ"معاداة اليسار"، إن لم يُتهم بـ"الرجعية" صراحة.
أهلا بكم في النظام الإمبريالي الجديد.
*أستاذ السياسات العربية الحديثة، والتاريخ الفكري بجامعة كولومبيا بنيويورك.