
الحوارنيوز- محليات
برعاية نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أقيم في مقر المجلس حارة حريك حفل توقيع كتاب “سردية الحرب الكبرى – رواية سيرية” لمؤلّفه الوزير السابق د. طراد حمادة، بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والنيابية والدينية والتربوية والقضائية والإعلامية وفعاليات اجتماعية ومهتمين.


وقدم للحفل الإعلامي د. روني الفا فقال في كلمته: تكَرَّمَ علينا هذا المساء بشيءٍ من حلوى مقرمِشَة لزومَ اشتهاءِ الروح. بخيلَةٌ أمسياتُ الكلام المضمَّخةُ بالكرامة، فأغلبُ ربطاتِ العُنُقِ في بلادنا تحوَّلَتْ إلى أرسِنةٍ لجَرِّ الدَّواب. كانَ كلُّ ما عليها أن تنظرَ إلى فَوق. أن تحبَّ الشمس، فإذا بها توصِدُ النوافذَ، تلعنُ الضوءَ وتلعقُ العتمة! سرديةُ الحربِ الكبرى” أمسِيَتُنا المتحدِّرَةُ من أصلِ الكرامة. سلعةٌ نادرةٌ نفتشُّ عليها بسراجِ الصَّبرِ وفتيلَةِ الانتظار. تأتينا على أَلسنَةِ من يقرأون الليلَةَ في رواية الدكتور طراد حمادة.

في حضرة طراد حمادة، نشعر أنّ الكلمات تستعيد معناها الأول، وتغدو المعرفة فعلاً تحرّريًا. هذا الرجل الذي حمل قلمه كما تُحمل الأمانة، كتب بوصفه شاهداً لا متفرجًا، وصانعًا لا عابرًا. في كتبه، كما في مسيرته، نجد الوطن حين يُفتَّش عنه في المتاهات، ونجد الإنسان حين يُوشك أن يضيع في ضجيج المصالح. طراد حمادة ليس مؤلفًا وحسب، بل مرآةُ زمنٍ ومعلّمُ أمل، يكتب كي نرتقي، ويوقّع كي نبقى أحياء في الذاكرة. اليوم نحتفي بكتابٍ يضيف معنى إلى وجودنا، وبصاحب فكر يضيف نوراً إلى دروبنا.
في حضور النائب إيهاب حمادة نكتشف أنّ السياسة حين تلتقي بالفكر تتحوّل من مهنة يومية إلى رسالة أخلاقية. هو ابن بيئة تعرف أن الكلمة مسؤولية، وأنّ الموقف يُبنى على قيم لا على مصالح عابرة. في مسيرته كما في خطابه، ظلّ صوته امتدادًا لوجدان الناس، لا صدى للضوضاء. يحمل المعرفة بقدر ما يحمل الهمّ العام، فيمزج بين الالتزام والوعي، بين الثبات والانفتاح. إيهاب حمادة لا يتكلم لكي يعلو، بل لكي يرفع الآخرين معه. حضوره اليوم هو امتداد لعلاقة عميقة بين الكتاب والفعل، بين القلم ومَن يحميه بالفعل.
مع الأستاذ عبد المجيد زراقط ندخل إلى عالم الكلمة الصافية، حيث الأدب ليس ترفاً بل موقفاً، وحيث اللغة تصير وطناً موازياً يحفظ المعنى من الضياع. في حضوره، نشهد كيف تتحوّل التجربة إلى حكمة، وكيف يصير الكاتب شاهداً على زمانه، وفاعلاً في تشكيل وعيه. زراقط هو أحد الأصوات التي تعطي للثقافة معناها الرسالي، يكتب ليقاوم النسيان، ويعلّم ليوقظ العقول. حين يتحدث، تتجاور في كلماته البلاغة والبصيرة، فيولد أفقٌ أوسع للقارئ والسامع معاً. حضوره اليوم ليس تكريماً له فقط، بل تكريم للكلمة التي وهبها عمره.
إيهاب حمادة
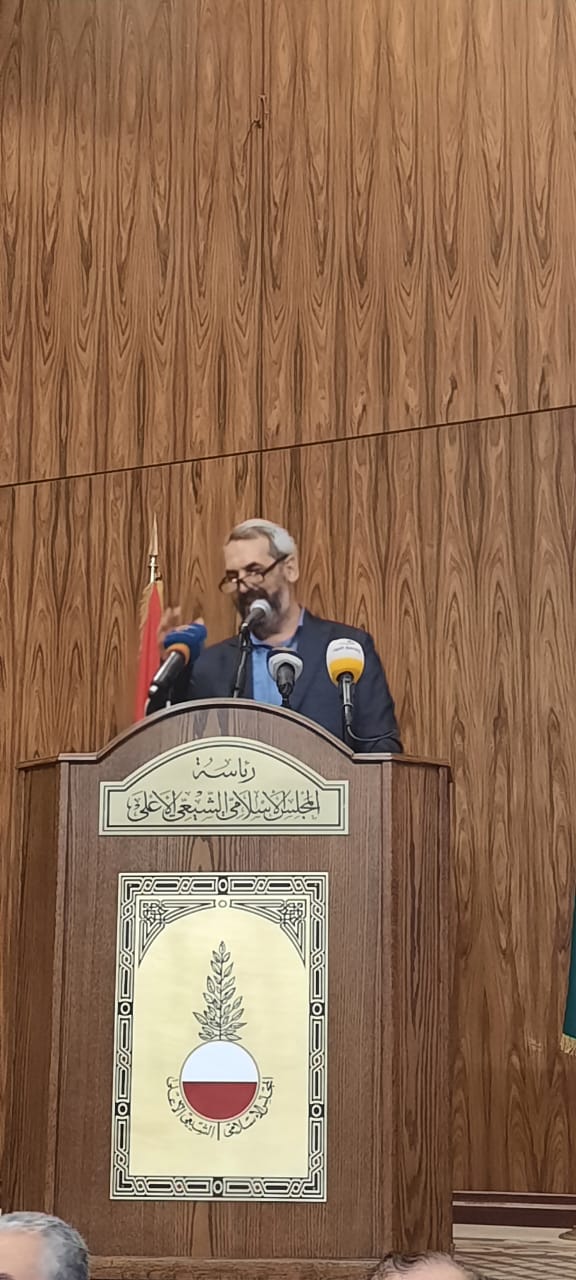
والقى النائب د. إيهاب حمادة كلمة قال فيها: حملت نفسي المتأرجحة إلى لحظة اكتمال طقس قراءتتي لسردية الحرب الكبرى, من شارع إلى شارع , من منزل إلى مقهى, من وجه إلى وجه, من مشهد إلى مشهد, كنت أقف مشدوها كأني أسترجع شريط أفكاري, خوفي, قوتي, هواجسي, تحليلي, مشاعري, توجسي, أحداثا هي أحداثي, هل يكتب عني, عنك,عنه, عنها, عنا! وعلى كل حال, هل أقرأ رواية يربط أحداثها خيطٌ دقيق, وشخوصا تتوزع صناعة الأحداث بين ثانوية ورئيسة, ناميةٍ متحركة, مركبةٍ أو بسيطة, أم كانت غائبة تماما ولكن نمّ عنها سياق, روايةً ذاتَ بناء سردي محكم موزعٍ على مشهد أولي وحدث مبدل ثم حبكةِ وخلوص,وِفاق ما عرف عن ترسيمة الرواية, هل ما أقرأه سردا, شعرا, هو سيرةٌ أم توثيق, أفكار, خلاصات في الفلسفة,فلسفة جديدة؟ قراءةٌ من مرجعية السياسة, أم كلُّ هذا في نسجة نوّال متقِن، وهل أقارب المنتج بحيادية وموضوعية, وفاق هذا المنهج النقدي أم ذاك, بنيويا, تفكيكيا, تاريخيا, نفسيا, دلاليا, سيميائيا, علاميا, أم كطريقتي وطريقة بعض منآ نحب ( أنا والدكتور طراد) في أكل الطعام ( خلطة), نبيّتها إلى اليوم التالي؟!.
لن أكون الآن ناقدا يرتكز إلى مدرسة نقدية بعينها, ولن تكون ورقتي أيضا مقاربة نقدية أكاديمية ترتكز إلى نظام متبع في مقاربة المنتج, النص, إنما سأقطف من الحديقة طبقا من كل زهرة, مع التركيز على نقاط بعينها ترسم رؤيتي لهذا المنتج.
فهل ينتمي هذا المنتج إلى أدب ما بعد الحداثة, أقله على مستوى الأسلوب ويتميز أدب ما بعد الحداثة كأسلوب بـ مجموعة من العناصر أهمها:
- التجزيء – وربما كان أهم عنصر في نصوص ما بعد الحداثة، التجزيء، يحيل إلى تكسير الحبكة والشخصيات والموضوع والمكان، فالحبكة على سبيل المثال، لا تتطور بطراز واقعي أو متسلسل، وإنما بشكل «وحدات من أحداث وظروف». مثال(ساندرا سنسيرو وروايتها «بيت شارع المانغا» – 1984، التي تتطور عبر سلسلة من الذكريات أو المكاشفات وليس بواسطة سرد تقليدي البنية).
- الارتباط الضعيف – الصدفة في قراءة النص (مثلا قراءة صفحات تنتقيها عشوائيا وبدون ترتيب أو نظام، أو برنامج يبدل ترتيب الصفحات داخل النص).
- البارانويا – تشير البارانويا لعدم الثقة بالنظام أو حتى عدم الثقة بالذات. وغالبا ما تعكس نصوص ما بعد الحداثة البارانويا بشكل يتضمن معارضة للسكون والثبات.
- ــ اللعب بالزمن والمكان: لا يعترف أدب ما بعد الحداثة بالحدود الزمنية أو المكانية الصارمة، حيث إن النصوص غالبًا ما تتجاوز الزمان والمكان التقليديين، حيث يمكن أن تجتمع أحداث من عصور مختلفة أو أماكن غير مترابطة في النص نفسه.
واسمحوا لي أن أسجّل مجموعة من الانطباعات السريعة التناسبة مع الحال والمقام, وإن كانت مزيجا من الانطباعات النقدية أو الخاصة من موقع المتلقي:
هل سردية الحرب الكبرى هي رواية ( الحرب والسلام لتولوستوي الحديثة أو الجديدة في مقاربتها وفي موقعها؟
تولستوي لا يصف الحرب فقط كأحداث تاريخية موضوعية، بل يُدخل رؤية فلسفية وشخصية عميقة من خلال:
- تجارب الشخصيات الأساسية
- بيير بيزوخوف الذي يخوض تجربة الحرب كمراقب، ويخرج منها بتحول فكري وروحي.
- التحليل الذاتي والوجودي يهيمن، خاصة في الفصول التي يتأمل فيها تولستوي، على لسان بيير أو أندريه، في معنى الحرب والقدر والسلطة.
- رواية “الحرب والسلام” تصف الحرب من خلفية ذاتية وإنسانية وفلسفية، لا فقط كحدث عسكري. تولستوي يُسائل معنى الحرب عبر عيون شخصياته وأفكارهم، وليس فقط عبر السرد التاريخي التقليدي.
يقول طراد حمادة ص 62 يقول خبراء الحرب ...وص 127 كيف أصف…
السرد في سردية الحرب الكبرى:
- إن السرد فيها يكاد يكون مذهلا في تسجيل تفاصيل دقيقة, تكشف عن معنى نفسي عميق, فكأن الكاتب تفحص الأمكنة تفحصا يشبه تفحص المودع فكأنه لن يراه مجددا, إما لأنه يقصف أو لأن الكاتب تأمله تأمل مودع( أطال الله بعمره) لذلك جاء حقيقيا دقيقا عاطفيا سريعا , مشهديا, محفوظيا صدقوني, إلى أبعد مدى:مثال ص 20 , وكذلك سردا احترافيا إذ أنه لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يغوص في النفس البشرية: مشاعرها، تناقضاتها، أسئلتها الوجودية., يقول د.طراد: ص 136 ( إن الاحتفاء) … وسرد فيودور دوستويفسكي في “الجريمة والعقاب” يكشف أعماق الضمير البشري.
- شاعرية السرد, وشعريته ربما ( مفهومان مختلفان) “شاعرية السرد“ تشير إلى لطابع العاطفي أو التأملي أو الوجداني في السرد، حيث يغلب عليه الحس الجمالي، واللغة الحالمة، والانفعالات العميقة.”
- المكان في السردية:
- المكان يصبح بطلاً عندما لا يكون مجرد خلفية صامتة، بل حين يُشارك في صناعة الحدث، ويكتسب معنى، ويؤثر في الشخصيات، ويتحول إلى رمز أو قوة فاعلة. في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح، يصبح نهر النيل ليس فقط مكانًا، بل رمزًا للهوية والصراع، يشارك في بناء الحدث. وهكذا العاصي والفرات والشارع والمقهى والجنوب عند طراد حمادة.
- لمن يبحث عن إجابات حول الحرب, ومستقبل البلد ( الإسناد وأولي البأس) أسباب, دوافع, أدلة, تحولات, يجد إجاباتها من العسكري الخبير والسياسي الشاهد, والمفكر المرجعي. ص 73.
- ولكي لا أطيل أسجل انطباعي الأخير في هذه المقاربة مراعيا الوقت والمقام: حين أنهيت القراءة , ومع آخر سطر وجدتني أدخل أدخل في بكاء شديد وصل حد النحيب, قد لا أملك ما يفسر ذلك لكن هذا ما حدث.
زراقط
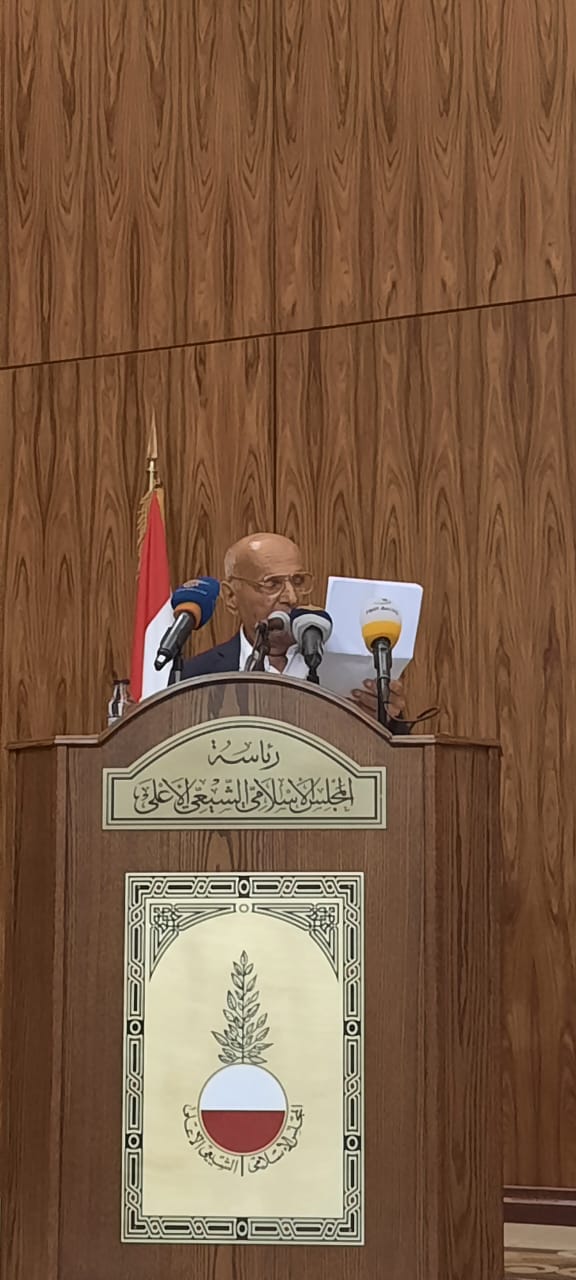
وقال د. عبد المجيد زراقط في مداخلته: ” سردية الحرب الكبرى، رواية سِيَريَّة ” هي الرواية الأخيرة، للأكاديمي المختصِّ بالفلسفة، الشاعر والروائي والقاصّ، والصحفي سابقاً، والناشط السياسي المقاوم، والوزير طراد حمادة…
فاتحة الرواية، والأمران اللذان تثيرهما
نقرأ، في الصفحة الأولى، من صفحات الرواية عنواناً هو: ” فاتحة الرواية”. يثير هذا العنوان أمرين:
أوَّل الأمرين استحضاره فاتحة القراَن الكريم، وهي الفاتحة، المعرفة، في حين تضاف ” فاتحة” هذه إلى الرواية، مايعني أنَّها تتخذ، في بناء الرواية، موقع البدء بالقصِّ وتشكيل فضائه ومنظوره، وبيان مايَفتح عليه هذا القصُّ من عالمٍ روائي هو عالم الحرب الكبرى، مايثير السؤال: هل من حربٍ كبرى وحربٍ صغرى؟ نجد إجابة عن هذا السؤال في سياق القصِّ، الذي يروي سردية هذه الحرب، أي أنَّ هذا القصَّ يقيم بناءً سردياً محكماً رائياً إلى عالمه المرجعي الذي يصدر عنه، كاشفاً إيَّاه، ناطقاً برؤية إليه.
وثاني الأمرين اللذين تثيرهما” فاتحة الرواية”، يتمثل في أننا نقرأ على غلاف هذا الكتاب تصنيفاً له هو” رواية سيرية”، في حين نقرأ في فاتحته، وتالياً في متنه، أنه رواية، فهل من فرقٍ بين الرواية والرواية السيرية؟ وما هو؟
بين الرواية والرواية السيرية
يبدو لي أن الفرق، بين هذي النوعين السرديَّين، يتمثل في أنَّ المرجع الذي تصدر عنه الرواية السيرية، أي المادة الأوَّليَّة التي تُصنع منها هذه الرواية هي وقائع سيريَّة يختارها الراوي من منظوره ، ويقيم منها بناءً روائياً متخيَّلاً من المنظور نفسه، ينطق برؤيته إلى العالم وقضاياه.
الوقائع السيرية، في هذه الرواية، مأخوذة، كما تفيد قراءتها، من سيرة الروائي الذي عاش الحرب وذاقها، ومن سيرة الحرب نفسها. نقرأ، في الرواية، على سبيل المثال:” أريد أن أكتب عن أحوالي، في هذه الحرب”( ص. ٣١)، ونقرأ كذلك :” من يوم شُغلت بفلسفة الوجود، وأنا والزمان صاحبان، ولكن منذ بدأت الحرب التي أروي سيرتها، أصبح الزمان يُعارض مسار أيَّامي، أصبحت أيَّامي خارج الزمان، لأنَّ الحرب…تُحيل كلَّ وقتٍ إلى رمادٍ ودمار”. وهذا يعني أنَّ المادَّة السيرية، أي المادَّة الأوَّلية نفسها، التي تُصنع منها الرواية، تسهم في تشكيل المنظور الرائي إلى العالم المرجعي، والمشكل العالمَ الروائي.
القارئ شريك المؤلف في إنتاج النصِّ
تبدأ فاتحة الرواية بالسؤال: من أين تبدأ الرواية؟ تأتي الإجابة عن هذا السؤال غير مباشرة. تأتي سرداً يُترك للقارئ أن يصوغ منه إجابة عن السؤال. وهذا يعني أنَّ الروائيَّ، ومنذ بدء مشيه مع القارئ، في مشوارهما المشترك، يجعله شريكه الفعلي في إنتاج النص، وهذه مزيَّة من مزايا هذه الرواية نتبيَّنها في غير موضع منها؛ وخصوصاً في الحوار الذي يكاد لا ينقطع بين الراوي وكثير من الشخصيات التي تسمَّى، وتبدي رأيها، ومنها: صالح وسليم وهمام وسالم وسمير وطارق وسامر…، فكأنَّ هذه الشخصيات تمثل وجهات نظرهي وجهات نظر القراء الذين يحاورهم الراوي في مايرى إليه، من قضايا، وخصوصاً قضايا عالم الحرب الكبرى.
ولا يخفى أنَّ القارئ، عندما يجد نفسه، شريكاً للمؤلف في إنتاج النص، يقبل بشغف على القراءة والمشاركة، وتبيُّن المسكوت عنه، أو الغياب، في حين يبقى للمؤلِّف أن يكتب المُعلن، أو الحضور، الذي يستحضر، لدى القارئ، المسكوت عنه / الغياب، والقارئ المعنيُّ، هنا، هو القارئ الحصيف، القادر على أن يتبيَّن مالم يُقل في ما يُقال.
بين الراوي والروائي
يؤدَّى القصُّ، في هذه الرواية، بضمير المتكلم، فالراوي الذي يوكل إليه المؤلف البث الروائي هو الشخصية الرئيسة في الرواية، وليس فيها من شخصيات أخرى سوى المحاورين وشخصيات الحرب المستحضرين، غير أنَّ قراءة الرواية تفيد أن شخصيَّتي الراوي والروائي تتحدان، وتصيران شخصية واحدة هي شخصية المؤلف طراد حمادة، وذلك في أماكن كثيرة من الرواية، ومنها الحديث عن غربته في أثناء الحرب وإقامته في مدينة نيس الفرنسية، وكتابته القسم الكبير من هذه الرواية فيها، فضلاً عن ديوان شعر عنوانه:” هكذا تكلم زارا”، ما يجعله يستحضر كتابة فريدريك نيتشه لكتابة كتابه:” هكذا تكلم زرادشت” فيها، في أثناء إقامته ستة شتاءات متتالية فيها.
البطولة المعاصرة
الراوي، كما قلنا، هو الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، ولا نقول البطل؛ إذ ليس من بطولة في هذا النوع من السرد، إلا إذا رأينا أن البطولة هي بطولة المقاومين المستحضرين إلى النص من دون أسماء، من نحوٍ أوَّل، وإلا إذا رأينا أنَّ البطولة في هذه الرواية، هي بطولة معاصرة يمكن أن يدلَّ عليها قول الراوي:” أصابعي التي تمسك بالقلم كانت ساخنة ومرتعشة، لكنَّها تَثْبُت، ولا تتعب حين أكتب”، فهل يمكن أن نعدّ الثبات وعدم التعب، في كتابة سردية الحرب الكبرى، نوعاً من البطولة، يمكن تسميته بالبطولة المعاصرة، وخصوصاً في عالم يريد التنين المعاصر، وهو تنِّين الاستعمار الغربي، يشنُّ حربه الكبرى على من يريد أن يعيش في وطنه، في حرية وعزَّة وكرامة، كما خلقه الله، سبحانه وتعالى، خليفة له في أرضه، ويسعى إلى أن يكون جديراً بالعودة إلى موطنه الأول، ويحظى برضى الله، عزَّ وجلَّ ورضوانه وجنته؟
النسق المضمر
ثم هل يمكن أن نرى، في المسكوت عنه/ الغياب، نسقاً مضمراً هو أنَّ المقاومين الذين يعملون على قطع أذرع هذا التنين، يمسكون بنادقهم وصواريخهم بثبات، ومن دون تعب، مثلُهم مثل الكاتب الذي يكتب سيرة خوضهم الحرب الكبرى التي شُنَّت على وطنهم الحبيب؟
الفقد، في هذه الرواية وتعويضه
تبدأ الرواية، كما جاء، في فاتحتها، بتحضير الأوراق، والقلمُ الذي لازم صاحبه عمراً حاضرٌ، والأصابعُ ثابتة، ولا تتعب، والطاولة مائدة تموج بالثمار، والكرسيُّ ينتظر العائد إليه، في اَخر الليل، بعدما بحث عمَّا يفقده، في ساعات النهار.
الفقد، إذاً، هو ما تبدأ به هذه الرواية، وإذ لا يعوِّضه البحث في النهار، تكون الكتابة تعويضاً له، في اَخر الليل، بعدما ينسى الكاتب كلَّ شيء، ويتفرَّغ لتعويض فقده، أي للكتابة بقلم لا زمه طوال عمراً، وأصابع تثبت، ولا تتعب حين تكتب، وقد تحوَّلت الرغبة في الكتابة، كما جاء في هذه الرواية، ” إلى مايشبه تعويضاً عن الألم الذي يحفر في أعماقي. أكتب روايتي على إيقاع نبض قلبي…”( ص. ٥٠) .
تجربة كتابة الرواية الواقعية، جديلة الذاكرة النشطة والخيال المتقد
يريد أن يكتب على إيقاع نبض قلبه رواية واقعية، أي رواية، كما يكتب، في مابعد هي” حكاية لفعلٍ يصنعه الناس، في هذه الأزمنة الصعبة من تاريخ البشرية”( ص. ٢٧) .
وهذه الرواية تلزمها، كما يقول، ذاكرة متَّقدة، والخيال لايصدق، في هذه الحال، لكن هل يمكن الفصل بين الذاكرة والخيال؟ وهل تملي الذاكرة على القلم ما لم يسهم الخيال في صنعه؟ وهل تستطيع الذاكرة أن تنقل الوقائع كما هي، أوأنَّ المنظور الذي يوظِّف الخيال هو الذي ينتقي الوقائع، ويصوغ منها الحدث، وينظمه، ويقيم البناء الروائي الناطق برؤيته؟
يجيب الراوي عن هذه الأسئلة إجابات مباشرة، فيقول، على سبيل المثال: ” لا تستطيع سردية الرواية أن تقدم لكم صورة الواقع، لأنه يبدو غريباً عجيباً، معقداً، ملتبساً…”( ص.١٤٧). ” ولا يمكن، في سردية الرواية، سوى إشغال الخيال لوصف البطولات وعظيم التضحيات…”( ص.١٢٢ )، ويقول، في موضع اَخر:” حقائق الميدان لا يمكن وصفها إلا بإعمال الخيال…” ( ص.١٢٣). ويصل به الأمر حدَّ القول:” كيف أصف ما يجري، وما هي اللغة القادرة على سرد وقائع حرب طالت حتى تشابهت فصولها…”( ص. ١٤٨).
ويجيب عن أسئلة هذه الإشكالية إجابة غير مباشرة، فيكتب:” أفتح درجي، أخرج أوراقي، أمسك قلمي، تنشط ذاكرتي، ويتوقَّد خيالي، الكتابة صنعتي وعشقي”( ص. ٨) .
اللغة السرديَّة
تلفت اللغة السرديَّة، في هذا المقطع السرديِّ، الذي يمكن أن نتخذه أنموذجاً للغة هذه الرواية السردية، فمعجمها اللغوي هو معجم لغة الحياة اليومية، وعباراتها قصيرة، بسيطة التركيب، تمضي في تتبُّع الوقائع كأنَّها رشق لها سريع، يمثل سرداً تصويرياً يرسم مشهد توحُّد نشاط الذاكرة وتوقُّد الخيال، ويعلن أنَّ من يمتلكهما تكون الكتابة صنعته وعشقه.
صانع الكتابة وعاشقها
الرواية هذه، إذاً، يكتبها صانعٌ للكتابة عاشقٌ لها، فيكون نصُّها وليد مهارة الصناعة وتوق العشق إلى اكتمال الجمال، لينطق برؤية إلى العالم كاشفة، والعالم، هنا، هو عالم الحرب الكبرى التي تستحضر إرث حروب الأزمنة الغابرة؛ حيث ظلت مدن الوطن الجميل الحبيب، صور وقرطاجة وبعلبك… أسطراً حمراء في كتب التاريخ، ظاهرة لعيون القراء، ما يطرح السؤال : حربهم الكبرى هذه علينا، هل يكتب التاريخ أسطرها كما كتب من قبل؟
كتابة أسطر هذه الحرب الكبرى غير المسبوقة في الزمن
يطرح القارئ هذا السؤال، ويجيب الراوي عنه: في فصول هذه الرواية: الأمر متروك للصانع العاشق في الميدانين: القتال وكتابة حكايته، ما يعني أنَّ هذه الحرب لم تنته بعد، وقد بدأت منذ استفاق التنين المعاصر، وغزا وطننا، وغرس في قلبه أداة من أدوات حربه، وهي حربٌ مستمرة. ومن هذين الأمرين، إضافة إلى أمور أخرى، هي الحرب الكبرى، ومالم يكتب من سطورها هو الاَتي، والمقاومون هم الذين سيكتبونه، وما يكتب، الاَن، هو ما ذقناه وعشناه، مايذكِّر بقول زهير بن أبي سلمى:” وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم/ وما هو عنها بالحديث المرجَّم”.
وفي هذه الحرب يشتدُّ التعلُّق القلبي بمنزل في الأرض،لا يكون إلا على سجادة ترابه الوجود الحقيقي الذي يستحق الحياة، والزمان فيه يجمع بين الماضي والمستقبل في الحاضر حتى يقظة الفجر التي يصنعها المقاومون نهاية لهذه الحرب.
وهذا يعني أنَّ ماكتب، في هذه الرواية، أملاه مسار الأيام، فهي، أي الأيَّام، تنتج أدبها الخاص، وما أنتجته أيَّام هذه الحرب أنَّها حرب كونية وجودية، غير مسبوقة في الزمان بين الحروب، ” تخلَّت عن كل قاعدة ، حرب لا أخلاق لها، ولا قواعد، ولا أسس، ، ولا مثال…”.
استحضار كربلاء
تبدو غارات هذه الحرب لصالح ، وهو يحاور الراوي، كأنَّها “سهام القوم إليكم”، فيحمل المقاوم سلاحه وجراحه ودمه وأنفاسه، ويرتدي قميص القاسم، ويقاوم…، مايذكِّر بكِّربلاء، الأمر الذي يجعل الراوي يقررأمرين: أولهما أنَّه بحاجة إلى وقائع هذه الأيام الفريدة في التاريخ ليواصل صناعة روايته، التي تفاجئه بأنَّها تصنع أحداثها، ولغتُها تصنع أسلوبها، وكلماتها تنطق وحدها، وحروفها تصنع أجنحة، وتعرج إلى السماء (ص.٥٥)، وثانيهما أنه ليس بحاجة إلى الفلسفة وطرائق إفصاحها، فالمؤلف المختص بالفلسفة، والذي يتخذ موقع الراوي، يتنحَّى عن موقعه الأكاديمي ليكون روائياً يكتب رواية واقعية، لكن هذه الرواية السيرية لم تخل من حضور للفلسفة والفلاسفة، من أفلاطون إلى أرسطو إلى الفارابي ومدينته الفاضلة، وهو، في كتابته، إنَّما يريد لوطنه الجميل الساحر الخلاب، يريد لوطنه الحبيب حريته وإعلاء كلمة الله في الأرض، والدفاع عن الوجود الحر، ومفتاح تحقيق هذا هو: قاوم …( ص. ٥٦ ).
في الختام
إن تكن هذه الحرب، حرب قَتلٍ لا قتال، وإن تكن ” سُنخيَّة كيان العدو هي العدوان”( ص.١٥٧) ، فليس سوى المقاومة ما يمنع الطغيان والقتل والتهجير والإبادة…، فهي التي تقضي على المعتدين، وتوقف رحى الحرب الكبرى عن الدوران ( ص. ١٢٠و١٢١ )، لأنَّها، في حقيقتها، “دفاع عن سلام الإنسان مع الإنسان، وتحقيق للوجود الذي فيه الحقُّ والخير والجمال، ولأنَّ كلَّ جَوْرٍ واحتلال إلى زوال”( ص. ١٧٣ ).
طراد حمادة

وفي الختام قال المؤلف د. طراد حمادة : لقد قلت ما اريد قوله في هذه السردية الروائية عن احوال الحرب الكبرى ، ولذلك اختصر في هذا المقام ما يقوم بمعرض الإشارة إلى كيفية كتابة هذه السردية السيرية ، ما الذي يفعله الشاعر والروائي المشتغل في الفلسفة وقد تقدم به العمر في زمن الحرب ؟ لا يجد وسيلة سوى الكتابة عن الحرب واحوال الحرب، وقد عرفت الاداب الإنسانية أشكالاً عديدة من الإفصاح فيما يسمى ادب الحرب في الشعر والرواية والفنون الجميلة وفي الفلسفة، ولعل زهير بن ابي سلمى كان ابلغ المفصحين عن حال الحرب في ماقاله فيها: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، عيش الحرب عيشاً ذاتياً، وجودياً ذوقاً بالحواس الظاهرة والباطنة. (عيشِ نقدِ )كما يعبر في اللغة الفارسية وهو كذلك عيش المقام والحال عند الصوفية.
تساءلت في فاتحة السردية عن كتابة الرواية وقدمت جوابها: ان الحرب هي التي تكتب روايتها. الرواية هي احداث ووقائع الحرب هي سرديتها الصادقة، الاحساس الوجودي في زمن الحرب يصنع ابداعه الادبي ويقدم سرديته في مواقف ومشاهد وحوارات وفلسفات وإبداعات تصنع سردية الحرب .
كتبت السردية في حالة حزنٍ شديدٍ وقلقٍ عميق على الوجود ،على بلدي ،وأهلي قومي وشعبي، حريتي ومصيري كلها كانت في دائرة حرب كبرى غير مسبوقة تهدد، وخلافة ادم في الارض وتطرح سؤال الوجود. ومصير الحضارة و مبادىء الاخلاق. ومسائل الاحتلال والعدوان وحق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير، وحرب الابادة الجماعية للجماعات الإنسانية، حرب الاعلام الضال، والخداع والغدر وتراكم الظلم والجور، وسيادة منطق الهيمنة والسيطرة في العلاقات الدولية، ومجافاة العدالة والحق والخير والجمال ومعادات حقوق الإنسان في الحياة والحرية .
هذه السردية تطرح اشكاليات فلسفية عالية حول هذه المسائل ، وهي تقدم حركة سيرية في اقامة الثبات في الحرب في الوطن وزمن النزوح القسري ، إلى مأساة الروح في غربتها الغربية، حوارات ذات طابع سياسي حول الاسئلة الاشكالية الاساسية التي تكونت في سردية الحرب، جعلت من السردية عملاً أدبياً إبداعياً ووثيقةً تاريخيةً لزمن الحرب وفصولها،هذه السردية كتبتها ناطقة بلسان الروح المتيقن من حقه في الوجود وفي الحريةً، وان هذا العالم سوف يبلغ دولة القسط والعدل ، زمن ظهور الامام، هو زمن القيام.
وبعد ذلك وقع حمادة كتابه للحضور.







