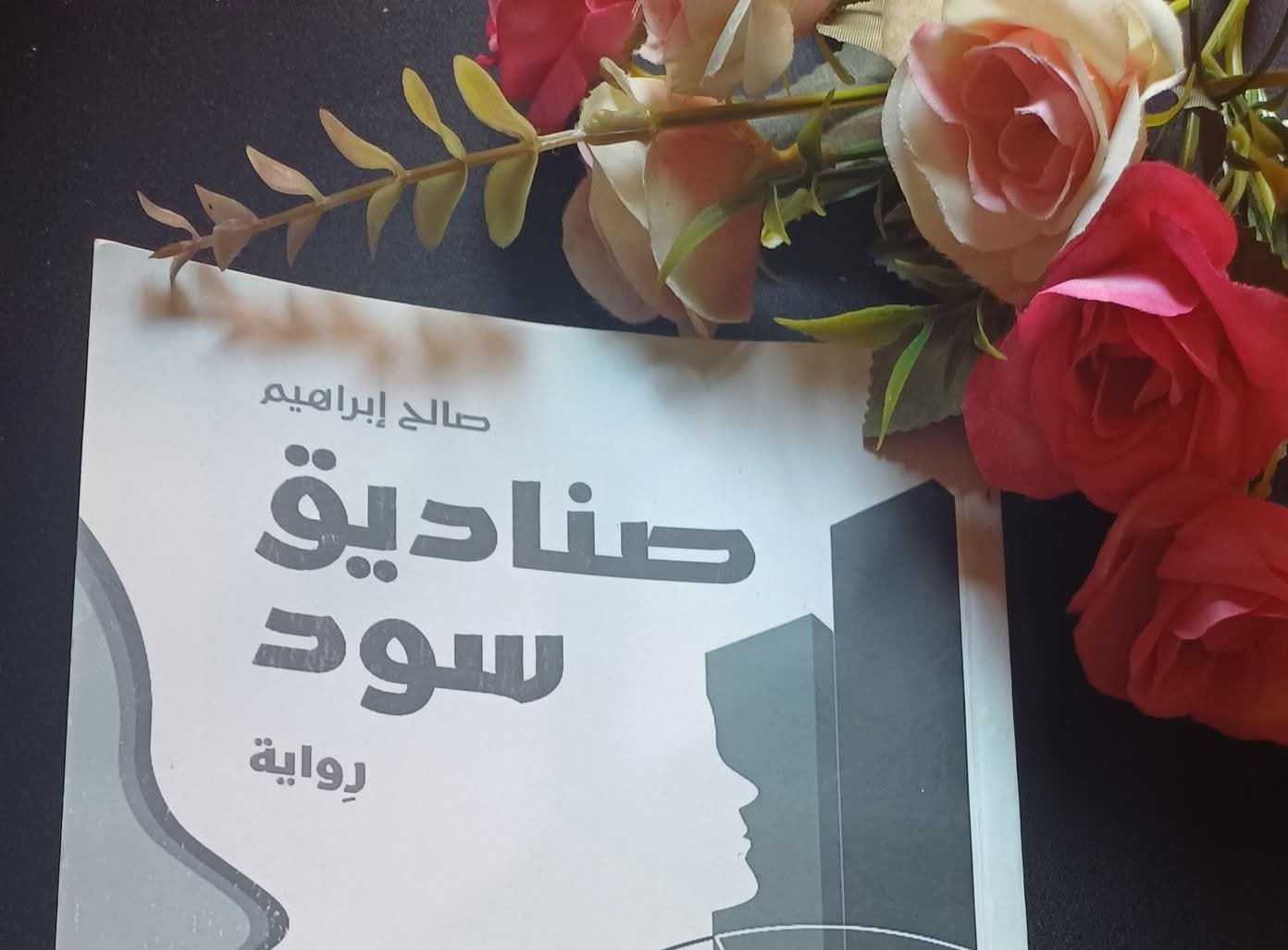
غدير سواري رمال * – الحوارنيوز
تمثّل رواية “صناديق سود”، للكاتب الدكتور صالح إبراهيم، أرضًا خصبة للدّراسة في أكثر من منحى، بصرف النظر عن الرأي الشخصي في الجرأة، وانطلاقًا من عين القارئ النّاقد الذي يتوخّى تحليل ما هو أعمق.
نبدأ بالعنوان ورمزيّته “صناديق سود”، والصندوق يشير إلى الانغلاق التام، فيما يشير اللون الأسود إلى العتمة. الصّناديق هي رمز لجماعات انغلقت على نفسها وأفكارها، فباتت غير قابلة للانفتاح على الآخر ولا محاورته، ما أدّى إلى اقتتالها وبالتالي غرقها في سواد الكراهية والعنف.
أمّا بالنّسبة إلى السّرد، فمعظمه قائم على تقنية الاسترجاع (التذكر) الذي حوى فضاءً زمنيًّا واسعًا.

من الناحية النفسية، بدت الشخصيات مأزومة غير مستقرة متشظية. مثلًا شخصية سارة وشخصية ربيعة، ربما تعرضت الاثنتان للاغتصاب، لكن واحدة قرّرت أن تنحو هذا المنحى برضاها (سارة)، أمّا (ربيعة) فكانت تشعر بالغربة الجسدية وعدم الرضا إلى حين التقت بمرجان، وشعرت قربه بالأمان وانفجرت باكية و”كورت نفسها كالسلحفاة” ص٤٢. وهنا إشارة إلى الحنين، إلى المرحلة الجنينية، ويمكن القول إنه نوع من النكوص، بحسب المنهج النفسي، كآلية دفاع لجأت إليها الشخصية بسبب عدم قدرتها على تحمل واقعها أو صدمتها الناتجة بعد وعيها بالأفعال الشنيعة التي كانت تقوم بها.
أما بالنسبة إلى ماضي الشّخصيّات وطفولتها، عانت شخصيّة مرجان أزمات عديدة في مرحلة الطّفولة وكبتًا نتيجة معاملة والده القاسية وجو أسرته الذي كان أشبه بساحة القتال بحسب ما ورد في الرواية، وقد عانى الحرمان مع أن أباه على قيد الحياة، بل كان يتمنى لو أنه ميت: “إن مرجان ابن ضيعه، أبوه دائم التّجهم، أمّه دائمة الحزن، علاقتهما علاقة مرّة، لا يجمعهما حبّ ولا مودّة، يكرهها وتكرهه، دائما التذمّر والصراخ، بيتهما ساحة معركة مفتوحة، أولادهما دائمو السّكوت والخوف والترقّب” ص٣٨ . هذه المأساة كلّها انعكست وأفضت إلى تشكيل شخصيّة غير سويّة في ما يخص العلاقة الجنسيّة السّاديّة، وذلك الأمر انعكس في القتال أيضًا “كان دواؤه المميت الملتوي”ص٣٨، وعدم قدرته على حسم تخصّصه الجامعيّ، فقد ظلّ يتنقّل بين الاختصاصات ولم يكمل ولا واحد منها.
أيضًا، شخصية سارة، فقد توفي والدها وتزوجت أمها برجل، ثمّ اضطرّت إلى العمل واغتُصبت، أدّى ذلك كلّه إلى ظهور مشكلات نفسيّة وتصرّفات غير سويّة.
بدت العقدة السّاديّة واضحة لدى سارة ومانع في علاقتهما في التلذذ بالألم والتعذيب، وبدا أثر انخراطهما في المعارك واضحًا حتى في ألفاظهما “احتل، سيطر، انتصارك…”. يمكن ربط ذلك بما هو أوسع في المجتمع المأزوم نفسه المقتتل فيما بينه، فالحرب الأهلية بين جماعات في وطن واحد، كل جماعة باتت تتلذّذ في قتل جماعة أخرى والسّيطرة عليها.
ومن آثار الحرمان والكبت الطفولي، قوّة مرجان وصلابته وقدرته على القتال وشجاعته لكنه كان كالأرنب لوحده، فهو شخصية منكسرة متشظية، تعاني عقدًا كثيرة، كان يتأتئ وينظر إلى الأرض، ويدير وجهه في أثناء النوم صوب الحائط، لكنه فاجأ المقاتلين جميعهم عندما خاض المعركة الأولى بشجاعته هذه الشّجاعة كلها ظهرت من ضعفه فعليًّا.
كما عانى مرجان الانفصام، ورد أنّه كان “ينفصل عن واقع القتال عندما يغنّي وينفصل عن كل واقع عندما يقاتل”.
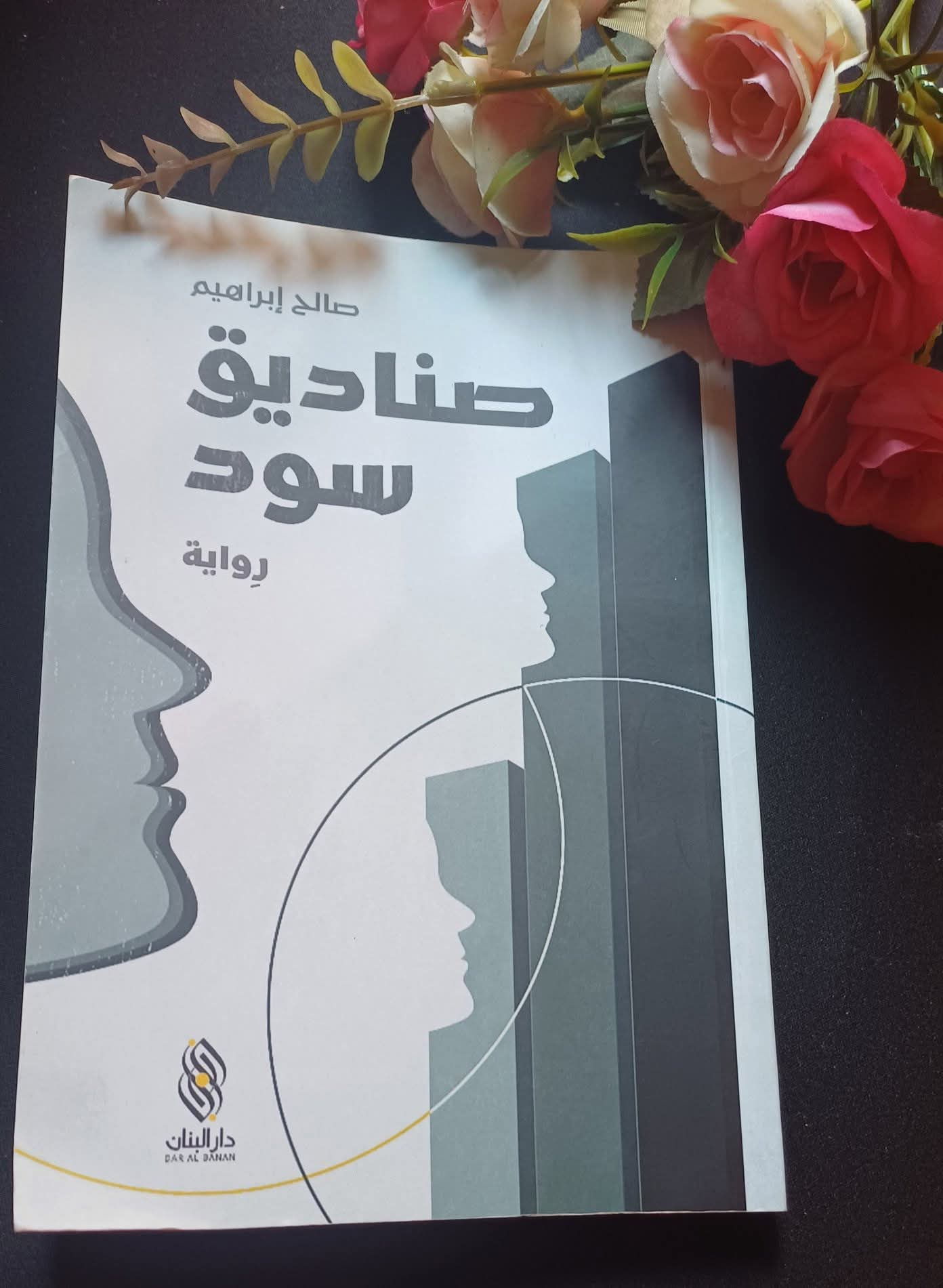
ينقل الكاتب لنا أنّ هذه الحرب الأهليّة في الحقيقة لم تفض إلا إلى النزاعات والدم والاقتتال، فالقاتل هو ذاته المقتول، والضّحيّة هي ذاتها المجرم في حال اقتتال طرفين من وطن واحد على عكس أن تكون حالة الاقتتال بين الطرف وعدوه. وبدا الاقتتال لدى الشخصية الرئيسة بتصريحها لأجل الاقتتال وحسب، حتى صرحت أنّه لا فرق إن قاتل في هذا الطرف أو ذاك، فالاقتتال لم يكن نابعًا من عقيدة معينة أو لهدف واضح.
ما يلفت الانتباه أيضًا، إبراز صدمتين تتعلقان بالسلطة الأبوية العليا للشخصية الرئيسة الأولى تتعلق بالطفولة، الأب وسلطته المدمرة لأسرته وتخليه عن رعايتهم ومسؤوليته تجاههم حتى عانوا اليتم في حضوره، ما جعل أطفاله يعانون الخوف والتشتت. والثانية، تتعلق بإبراهيم عندما لجأ إلى قيادة حزبه وتخلت عنه ثم اكتشف صدفة وهو يعمل في المطعم أن رئيس حزبه ينفق الأموال على السهرات والمأكولات الفخمة غير آبه بعناصره وما يعانونه، وفوجئ وصدم به في أثناء عمله في المطعم أنّه أيضا شخص سلطوي فاسد يترك أبناء حزبه يعانون الخوف والتّشتّت والضّياع.
بالعودة إلى موضوع العلاقات، أيضًا، صرحت الشخصيّة الرئيسة المتمثلة بمرجان أنها تبحث عم صورة والدها في كل سلاح، وعن أمها في كل النساء، تبحث عن صورة أخرى للأم. هو لا يحب، لكنه دائم البحث عن علاقات، عن كل امراة تشعره أنه رجل؛ لذلك أصبح أكثر من رجل،
هنا يظهر الانفصام واضحًا. وعقدة الحرمان تلك دفعته إلى إقامه علاقات متعدّدة، فبرزت تلك الشّخصيّة غير سويّة وظهر ذلك في أفعالها وأقوالها وأقوال الشخصيات عنها. تقول “سارة” لمانع: “أنت مبعثر في حكاية مبعثرة” ص ٢٦.
بالعودة إلى العلاقات، علاقة مرجان بربيعة علاقة حب واحتواء، أمّا علاقة إبراهيم بماري، فكانت مادية، لكن ماري كانت عاملا مساعدًا في كشف ذات إبراهيم أمام نفسه، تقول له: “على الرغم من شكلك الذي يوحي بالقوة، أنت ضعيف…لا تغضب، أحاول إخبارك عن نفسك” ص٨٣. وعندما حاولت إذلاله وإعادته عامل تنظيفات بالمطعم وقالت له بأنه يلهث خلفها وأن علاقتهما من غير الممكن أن تكون علاقة حب، صرح بأنها لم تكن سوى وسيلة يسد به حرمانه (آلية سد حرمان عبر الجسد).
لقد طرحت الرواية موضوعات مهمّة، عن الحرمان والفقر وهزيمة الأمّة والوجدان الشخصيّ، والتّخلّف، إذ أشارت إلى أن الهزيمة تفضي إلى الشعور الدّائم بالخصاء وتدفع إلى التشتت، يشير إلى أن ثلث لبنان تقريبًا تحت الاحتلال، وهو تصريح واضح بالعقم الفكري، وعدم القدرة على التقدّم في ظلّ الاقتتال.
لقد صرّحت الرواية عبر حوارات جرت بين مجموعة من الرجال بالموقف الأميركي المدمّر دائمًا المتخفّي تحت غطاء المنقذ لكنه لا يوصل إلا إلى الدمار “فالأمريكان لا حليف لهم، الآن يستعينون بهم وغدًا يدمرونهم الدولة تلو الدولة، المجتمع تلو المجتمع”، وفي مثال آخر: “الغرب لا يفكر إلا بأمرين: مصالحه وأمن الكيان الصهيوني، وهو يفعل لذلك ما لا يمكن أن نتخيله من مؤامرات وحروب وإبادات جماعية. وكل ما يمكن أن يخطر على بالك من مكر وغطرسة وشيطنة” ص١٢٨.
على مستوى فضاءات الأمكنة، لوحات وصور الكنائس الفلسطينية المعلقة على جدار غرفة الشيف الفلسطيني الصغيرة تحول هذه الغرفة الصغيرة جغرافيا إلى فضاء رمزي واسع تعويضي عن وطنه فلسطين، بل وتشكل لوحة القدس القديمة وحدها فضاء مكانيا واسعا، يقول الشيف مشيرا إليها: “أنا من هنا كل يوم أسترجع
أحداث طفولتي في تلك الأمكنة”، يضع يده على قلبه “القدس هنا” ص٧٣.
أمّا إبراهيم كان يخاف على نفسه من أن ينصهر في مكان عمله الذي لم يتآلف معه “أخاف أن يمتصني ذاك المكان اللزج”، فيما يجد مكانًا مريحًا يتآلف معه ويشعره بالطمأنينة والسكينة، وهو بستان جدو لبيب، يقول:”لو أبقى معه ويمتصني المكان فلا يراني أحد ولا أرى أحد”. هو متآلف مع المكان حد الذوبان، يدفعه المكان إلى نسيان همومه كلها وأزماته واسترجاع اللحظات الجميلة والوجوه المحببة والأيادي التي قدمت له المساعدة… ثم يدفعه المكان إلى السجود لخالق جميل… ثم إلى تساؤل داخلي “إذا جاء المقاتلون إلى جدو لبيب فهل سيكفون عن القتال؟”ص ١٠٠، ويكمل حواره الداخلي “وددت لو أقول له إن وطنا تتناتفه أيادي السفاحين والنهابين والتجار والخونة لا يصنع لك خيمة من طمأنينة” ص١٠٠. الكاتب هنا أعاد فلسفة المكان، فالوطن على اتساعه لا يصلح لأن يكون خيمة ضيقة في ظل الاقتتال، فيما فسحة جدو لبيب الضيقة تتسع لتكون وطنا آمنا بحبه وعطفه وطيبة قلبه. بعد ذلك، يغادر ابراهيم جدو لبيب الذي يشبهه بالرهبان، فيحضر في ذهنه الشيخ رضا المتمسك بأرضه، دائم الابتسامة، الحنون، ويتساءل: “أين هو من هذا الدمار؟”، “لو جاء إلى هنا فسيختار جدو لبيب، لو التقى به جدو لبيب لظل عنده حتما”ص١٠١. توالت الأسئلة في ذهنه وحواره الذاتي، بهدف الدعوة إلى نبذ الطائفية والقول بأن خلاص الإنسان في تخلصه من عصبيته ومحبته للآخر، وحل المشكلات ينبع من إصلاح الذات داخليا بالدرجة الأولى.
فضلًا عن ذلك؛ دعا الكاتب، عبر استرجاع قصّة هشام، إلى ربط التّاريخ السّياسيّ بالأحداث الموجودة وبالأزمات الفكريّة، والوقوف عند الأسباب في سبيل محاولة معالجتها، ضرورة معالجة أزمة النّظام السياسي والبحث في تردّي أحوال الأمّة، لا درس التّاريخ كأحداث فقط، فالحياد لا يفيد و”للتّاريخ روح عليناالإمساك بها”. تاليًا؛ ما إن درسنا التّاريخ وفهمنا أسبابه “يصبح دارس التّاريخ صانع المستقبل”؛ لأنّه يعمل على معرفة أسباب المشكلات، فيجد حلولًا لها.
وفي النهاية، الرواية كلها مبنية على تكسر الزمن، شخصيات مأزومة، فضاءات رمزية تتسع وتضيق بحسب فاعليتها وفيها الكثير والكثير من الموضوعات الغنية التي لم يُشر إليها هنا.
*مدققة لغوية وناقدة أدبية





