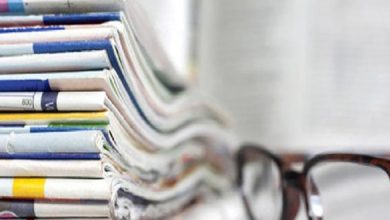الحوارنيوز – صحافة
كتب عبد الحليم فضل الله* في صحيفة الأخبار اليوم:
يُطرح مصير المحور على محكّ حَرْبَي غزّة ولبنان وتطورات سوريا، انطلاقاً من النظرة التي ترى فيه مجرّد خطّ إمداد لوجستي من طهران إلى شرقي المتوسط. لكن المحور في جوهره سياسي ومساحةٌ حرّة تقع خارج قبضة الهيمنة، وتجمع بين فئاته قضايا عابرة لحدود الدول ومؤثّرة في مجريات الأمور داخلها. كان الصراع مع إسرائيل وما يتفرّع عنه من تحالفات ومشاريع في صدارة القضايا التي شدّت أواصر القوى والدول المشكّلة للمحور، ومثّلت حرب غزّة اختباراً فعالاً لصدق نوايا أطرافه. ويعوّل هؤلاء على تفاعل دول المنطقة ما بينها بوصفه البديل الصحيح من الاستعانة بالخارج، وهذا لأسباب مبدئيّة وللمخاطر التي تنطوي عليها الإستراتيجيّات الأميركيّة وما تجرّه القواعد العسكريّة من تبعيّة وحروب.
ويمكن القول إنّ ظهور المحور كان استجابة متأخرة للتحديات الخارجيّة، وللتهديدات التي تمسّ المنطقة بأسرها. وبوجوده عوّض بنحوٍ ما عن افتقار الدول العربيّة للنية والرغبة وربما القدرة على صوغ سياسات جماعيّة في وجه الأخطار المشتركة، أو حتى تفعيل ما يجمعها من اتفاقات ومعاهدات. نشأ المحور في تاريخ لاحق على انبثاق مقاومة الاحتلال في البلدان التي تعرّضت له أو عانت من الوجود الأجنبي (لبنان والعراق وفلسطين). ولا يخلو الأمر من علاقة سببيّة وجدليّة في آنٍ، فتعاظم قوى المقاومة وتراكم إنجازاتها زاد من تركيز التحالف الغربي عليها وضخّم تدخلاته في الدول التي تنتشر فيها، والتدخلات الخارجيّة كانت تقوّي اللُّحمة بين القوى والجماعات والدول الرافضة والممانِعة والمقاومِة للسيطرة الخارجيّة ويقوّي حضورها في بلدانها. ولا نغفل وجود عوامل محلّية وذاتيّة فرضت نفسها. لقد أوجدت حروب المشرق في سوريا والعراق مناخاً مناسباً للعسكرة، لكنّها لم تكن مفصولة عن شهيّة الغرب المفتوحة لابتلاع المنطقة أو على الأقل منع تسرّبها من بين أصابعه. والمثال الأوضح على ذلك الحرب السورية، التي لها بطبيعة الحال محرّكات داخليّة، لكن لم تكن لتُخاض بهذه الشدّة وطوال ذلك الوقت، مقارنة بحروب أهليّة مماثلة ومتزامنة معها، لولا تفاعل الحدث المحلّي مع الأطماع الخارجيّة. وفي العراق أيضاً أُعطيت حركات التكفير مساحة واسعة للجم النفوذ الإيراني، ما قوّى تنظيم «داعش» بغضِّ نظرٍ أميركي تارة وتواطؤ معلن تارة أخرى. نلاحظ أنّ قوّة التدخل الخارجي تزداد عندما تضعف الأدوات المحلّية التي يملكها الغرب وتتعثّر مشاريعه. تتشدّد واشنطن في فرض العقوبات كلّما قلّ حضورها المباشر أو حضور أتباعها في الدول موضع الاستهداف. في سوريا صارت العقوبات الوسيلة الأنجع لفرض الإيقاع الأميركي على الأحداث بعد تراجع القتال، وكانت ثمرة ذلك في نهاية المطاف سقوطاً مدوّياً للحكم السابق. وفي لبنان أدّت العقوبات المباشرة وغير المباشرة إلى المسّ بالاستقرار الداخلي المبني على تفاهمات كان حزب الله طرفاً فيها حيناً ورافعة لها حيناً آخر.
الدول المتأرجحة
لنعد إلى العبارة الواردة أعلاه: «المحور مساحة سياسيّة خارج قبضة الهيمنة». يصعب في التوازنات العالميّة الحاليّة قيام نظام سياسي يتعارض مع المصالح الغربيّة حتى لو كان ديموقراطيّاً وليبرالياً بمعايير الغرب نفسه. ولا يتورّع الأخير عن جباية أثمان باهظة من دماء مناوئيه ومعيشتهم إذا لاقى معارضة صُلبة له. وإزاء ذلك يواجه باقي العالم، ممّن لا يريد خوض معموديّة النار لصدّ الغرب، خيارات محدودة تتقاسمها ثلاث فئات من الدول يمكن وصفها بالخاضعة والمتحوّطة والمتأرجحة.
تنسج الفئة الأولى من الدول سياساتها من خيوط الطاعة والانصياع للرغبات الدوليّة، فتقف عند حافّة الهاوية من دون الوقوع فيها، وترى في ذلك ملاذاً آمناً لها. لنراقب وضعيّة دول المنطقة الدائرة في الفلك الأميركي، فهذه يجري إنقاذها تباعاً من الإفلاس بحزَم تمويل متكرّرة من المؤسسات الدوليّة وغيرها، كما أنّها تحظى بالحماية من السقوط السياسي. وتأتي هذه الحماية على شكل إدارة دقيقة لانتقال الحكم من يد إلى يد، أو بتجديد الطبقة الحاكمة في تلك الدول إذا فقدت أهليتها أو تمنّعت عن تطبيق البنود الأصعب في الأجندات المفروضة عليها. لكن لا حماية دائمة، ولا شيء يضمن الوقوف في المنعطفات عند حافّة الهاوية من دون الانزلاق فيها. في عامَي 2011 و2013 فتحت أحداث مصر مثلاً نافذة ترميم مشروعيّة النظام، وها هي تعتاش الآن على دورات متتالية من قروض المؤسسات الدوليّة والاستثمارات الشبيهة بالقروض، ولا ندري ما الذي سيكون عليه المستقبل السياسي لمصر والأردن، إذا أصرّا على رفض تهجير الفلسطينيّين، وما التبعات المحتملة عليهما لعودة صفقة القرن إلى رأس أولويّات القادم الجديد إلى البيت الأبيض.
لنعترف هنا أن الضلع السياسي كان محتجباً، لا بسبب المقاومة التي فرضت نفسها بقوّة في الميدان، بل لفهم مجتزئ للسياسة. كان الظنّ أنّ أخذ مسافة من قضايا الداخل بتشعّباته وتفاصيله يحصّن فضاء المحور من تبعات ما يجرّه الصراع السياسي من استنزاف
التحوّط هو خيارٌ آخر لدول تريد التملّص من ضغوطات الغرب من دون تحمّل تبعات أفعاله، وتستند في ذلك إلى ما تتمتّع به من قدرات ومن علاقة تحالفيّة مع واشنطن تمنحها قدرة مقبولة على المناورة معها. ومع ذلك فإنّ أبعد ما تصل إليه الدول المتحوّطة هو أخذ مسافة مؤقتة من الصراعات التي ينخرط فيها الغرب من دون الوقوف في الصفّ المعادي له، وغالباً ما تنتظم هذه الدول في الطابور عندما يُدقّ النفير في واشنطن ويَضرِب موفودها اليد على الطاولة. والدول المتحوّطة إذ تنأى بنفسها عن قضية ما فإنها تؤدي أثماناً مضاعفة في قضايا أخرى. لم تجارِ السعوديّة واشنطن في مطالبها المتّصلة بالحرب الأوكرانية لكنها في غضون أشهر قليلة من الآن ستواجه مطلباً حاسماً بالتطبيع الشامل مع العدو من دون حلّ الدولتين. وتمايزت الهند في موقفها من الحرب الأوكرانيّة، بل جعلت نفسها محطّة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها تلتزم وظيفة محوريّة في احتواء الصين ومنافسة مشروعها الاقتصادي (الحزام والطريق) والانخراط في مشاريع بديلة (الممرّ الهندي).
وفي العموم تتّصف سياسات الدول المتحوّطة بعدم الثبات والحذر وتحرص على أن لا يقودها تنويع الخيارات إلى التأثير في تموضعها الثابت ضمن المعسكر الأميركي. وما يعنينا في السياق هو الدول المتأرجحة التي يتعايش فيها على نحو لا يخلو من صراع اتجاهان متعارضان؛ فمؤسسات هذه الدول ترتبط بالغرب، لكنها تضمّ في الوقت نفسه قوى وازنة معارضة له ورافضة لهيمنته (لبنان والعراق). ويخلق هذا التوازن مساحة سياسيّة داخليّة لا يمكن للوصاية الخارجية أن تخترقها إلّا بالحرب أو العقوبات والحصار والتضييق الاقتصادي. بقولٍ آخر، تميل الحكومات في الدول المتأرجحة إلى الغرب لكن سياساتها تخضع للضبط والتعديل من قبل القوى المناوئة له. وهذا ما تفعله بالضبط قوى المحور التي تملك في دولها ما يكفي من القوّة والحضور الشعبي لجعل مساحتها الخاصة مستقلة وحرّة، وتستعمل هذه المساحة للتأثير في مجريات الأمور في بلدانها. ولأنها كذلك فإنّ بوسعها أن تكون طليعة مشروع إصلاحي تنموي لا ينبثق من مصالح الغرب ولا يقطع بالضرورة معه، وأن تفرض إيقاعها على السياسات العامّة لدولها من داخل مؤسساتها بدلاً من قرع أبوابها من الخارج.
السياسة بمعنى أوسع
إنّ ما يجمع أطراف المحور هو أهداف ورؤى تتحقّق بالمقاومة والقتال تارة وبالصراع والمشاركة السياسية تارة أخرى. لنعترف هنا أن الضلع السياسي كان محتجباً، لا بسبب المقاومة التي فرضت نفسها بقوّة في الميدان، بل لفهم مجتزئ للسياسة. كان الظنّ أنّ أخذ مسافة من قضايا الداخل بتشعباته وتفاصيله يحصّن فضاء المحور من تبعات ما يجرّه الصراع السياسي من استنزاف وتشتيت للانتباه عن الأهداف العليا. تركّز قوى المحور على القضايا الإستراتيجيّة والمبدئيّة الرئيسيّة وتخوض من أجلها أشدّ المعارك، كرفض التطبيع ودعم الفلسطينيّن ومجابهة التدخلات السياسيّة السافرة في شؤون بلدانها ومقاومة الاحتلال أنّى وُجد، لكنها تمتلك اهتماماً أقلّ بالقضايا التي لا توضع بداهة في مقام القضايا الإستراتيجيّة الكبرى.
وهذا ينطوي على ثلاثة أنواع من التقديرات التي تحتاج إلى مراجعة:
أولاً؛ إن حماية المساحة الخاصة بالمقاومة تزداد صعوبة وكلفة كلّما اشتدت وصاية الغرب على حكومات الدول التي تنشط فيها، والمثال الأخير على ذلك سقوط حكم الرئيس بشّار الأسد في سوريا والتهديد الذي تتعرّض له فصائل المقاومة في العراق، والمحاولات الجارية لتغيير الاتجاه في لبنان.
وثانياً؛ تتفاعل القضايا السياسيّة التفصيليّة مع القضايا الإستراتيجيّة باطّراد بما يزيل الفوارق بينها في المنعطفات، وبالخصوص إذا وُجد من يستفيد من هذا التفاعل. أزمة الفساد في لبنان التي يمكن وضعها في خانة قضايا السياسة اليوميّة بدأت تتحوّل إلى تحدٍّ إستراتيجي منذ عام 2015 وصولاً إلى انتفاضة تشرين 2019 وما نتج منها من عواصف وأعقبها من انهيار. ويحصل العكس الآن بوجود من يحاول ترجمة التهديد الناتج من العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى حقائق سياسيّة. وبالعموم لا فاصل واضحاً ومستقراً بين مراتب الخطر السياسي والإستراتيجي والوجودي التي يمكن أن تتداخل في ما بينها على نحوٍ مدمّر.
وثالثاً؛ لا يمكن تفكيك الممارسة السياسيّة المتكاملة والمعقّدة بطبيعتها، إلى عناصر متفرقة قابلة للتجزئة وإعادة التركيب. هل يمكن في لبنان فصل النظام الانتخابي عن فهمنا للمواطنة؟ إلغاء الطائفيّة السياسيّة عن شكل نظام الحكم؟ السيادة عن التعيينات؟ تسوية الأزمات الماليّة والاقتصاديّة عن طريقة عمل مجلس الوزراء ونظامه الداخلي؟ انفجار المرفأ عن المحاصصة؟ جذب الاستثمارات عن استقلاليّة القضاء وتفعيله؟ المشاركة في الحياة البرلمانيّة عن المشاركة في الحكومة؟ تطوير آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسات عن امتلاك رؤية وطنية سليمة للسياسات الدفاعيّة والخارجيّة؟ سدّ الثغرات الدستوريّة التي تسمح بالتعطيل عن التدخّل الخارجي في الانتخابات الرئاسيّة وتشكيل الحكومات وتسمية الوزراء؟ حماية الحدود ومواجهة المخاطر الخارجيّة عن انتظام الحياة السياسيّة وتكريس ديموقراطيّة النظام؟
أفق جديد
بقولٍ آخر، إنّ قوام المحور هو الاشتراك في رؤية موحّدة لقضايا تمسّ فهمنا لطبيعة الدولة العربيّة ومستقبلها ومعنى المواطنة والعقد الاجتماعي اللذين تستند إليهما والقاعدة الماديّة والتنموية التي تقوّي حضورها وفهمها لموقعها ودورها في العالم. تحتاج هذه الرؤية إلى مشروع متكامل ينقل الصراع من حلبة العصبيّات والمخاضات الوجوديّة، إلى مضمار المنافسة على النهوض بالمستقبل في مجالات السيادة والاستقرار والعدالة والرفاه، وما يتفرع عنها من سياسات وتحالفات وإستراتيجيّات. والتشابك قائم بين مجالات النهوض المذكورة التي يجب أن تجتمع في نهاية المطاف داخل الإطار في صورة واحدة.
إنّ تقويّة الأسس الدفاعيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والإنتاجيّة للدولة يحلّ معضلة التعايش المستحيل بين التقدّم والازدهار من ناحية والتبعيّة والتعرّض الدائم للعدوان من ناحية ثانية، أي إنّ علينا أن نعثر على النموذج الذي يعطينا الرفاه ولا يفرّط بالسيادة والقرار. وهذا يعطي قوى المقاومة فرصة أن تدلو بدلوها وأن تضيف من تجربتها شيئاً لا يملكه الآخرون. إنّ فكرة الدولة لا تكتمل، بل لا تتحقّق من أساسها، إذا حملنا قضية السيادة على غير معناها أو افترضناها موجّهة إلى الداخل لا الخارج كما يعتقد مناوئو المقاومة، كما أنّها لا تتحقّق من دون قصّة نجاح تظهر في يوميّات الناس ومعيشتهم. إنّ خوض تجربة النهوض بمفتاحيها الجيوسياسي والاقتصادي معاً هو المطلوب، مع أنّه أصعب بكثير من الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، وهو ينطوي على معاناة لا بدّ منها، مردّها رفض الرؤية الإمبراطوريّة للعالم وما تنطوي عليه من سياسات داخليّة وعلاقات خارجيّة وتوزيعٍ للأدوار في العالم.
المعركة ما زالت قائمة والجبهات لم تهدأ بعد، لكنّ هذا النقاش ليس سابقاً لأوانه، إذ يُراد أن تكون السياسة استمراراً للحرب، ليس بالانفراد بالسلطة والقرار فقط، بل أيضاً في احتكار تفسير الأحداث والهيمنة على الرواية. وسيخرج من يقول إنّ التاريخ في المنطقة قد انتهى لمصلحة النموذج الذي يرى أنّ التخلّي عن السيادة بمعناها الأوسع هو الشرط اللازم والكافي للانتقال من ضفة الاضطراب والفقر إلى ضفة الاستقرار والرفاه، وسيضيف آخرون أنّ النجاة ستُكتب لمن اختار الانصياع والطاعة فيما يسقط الباقون. لكن التاريخ مفتوحٌ على نهايات مغايرة، وهو رهن إرادة الشعوب التي عبّرت عن وجودها في معموديّات دم ونار وستقول كلمتها وترسم مستقبلها بنفسها في نهاية المطاف.
* رئيس «المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق»