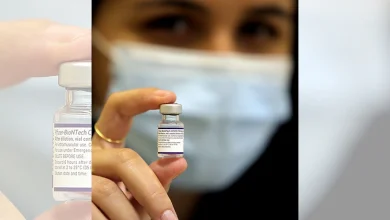مفردات من الواقع اللبناني: بين السخرية والأسى

كتب حيدر شومان:
هناك مصطلحات شعبية وكلمات وجمل اختص بها اللبناني عن غيره من مخلوقات الله المنتشرة فوق أصقاع البسيطة، تحدِّث جلياً عن واقع حاله ومعيشته المتعلقة بشؤون الحياة وشجونها، عناوينها العريضة وجزئياتها الصغيرة.
فعند انقطاع التيار الكهربائي تتعالى الصيحات: "أهذا إشتراك أو دولة؟"…"اطفوا البراد أو الغسالة أو المكيِّف"… "أحدهم عالق في المصعد"… وتجد دوماً على الشرفات من ينادي أي مار في الشارع ليتكرم ويرفع الديجانتير… وهذه حالات لا تجدها في بلد متحضر أو يلامس الحضارة لأن الكهرباء فيه واقع يعيش بين الناس، في حركاتهم وسكناتهم، ليلهم ونهارهم، ولا يغيب عنهم مهما اجتاحتهم النوائب أو عصفت بهم الرياح العاتية، أو السيول العارمة، أو الصواعق الحارقة… وهذه حالات لا تجدها أيضاً في بلد متخلف، انقطعت عن أهله الكهرباء ساعات أو سويعات، فيبتكر أهله حلولاً منها السرقة من كابلات الدولة الممتدة في الشوارع، ومنها الاستعانة ببطارية السيارة والتوصيلات الكهربائية الحلزونية التي تسير على جدران البيت من غرفة إلى أخرى، ومنها اللجوء إلى الطريقة الفضلى الملائمة لعصر الحداثة والتحديث والعولمة، الاختراع الاستثنائي: الاشتراك.
ومن ابتكارات اللبناني وإبداعاته، التغلب على انقطاع الماء، أكان الانقطاع دائماً أو موسمياً، للشرب كان الماء أو لغير الشرب. فبعد الخزانات الحديدية الكبيرة التي كانت تصطف شامخة في الشوارع والأزقة، ويصطف الناس أمامها لملء ما يمكن ملؤه من عبوات فارغة، بدأت أرتال الدرجات النارية التي تجر وراءها صناديق تحمل قناني المياه والجالونات البلاستيكية تجتاح الطرقات والأرصفة والعمارات لنقلها إلى البيوت، وهو ما يعرف عند الغرب بالديليفيري، ولكنه على الطريقة المحلية، ولن يتخيل أحد في الغرب أن بيوتنا في لبنان تعيش في كثير من الأحايين دون ماء.
ولا حاجة للاستفاضة أكثر في الحديث عن اشتراك الستالايت، حيث تصلنا الأقنية المشفرة، والانترنت والخيارات المحدودة، وغيرهما من التفاصيل الجزئية من هنا وهناك، والغرائب المبتدعة المبتكرة وكلها بكل فخر من قبيل: "صنع في لبنان".
ثم نأتي إلى الممارسات الخاصة التي تثير الضحك حتى البكاء، وتثير البكاء على قاعدة شر البلية ما يضحك، حيث نرى أن الإبداع الفردي قد أسس لتنظيمات فوضوية، أو لفوضى أصبحت منظمة منتظمة، ومثال ذلك النقل العام وآثاره العامة والخاصة. فلم تسعَ الدولة لحل مشاكل النقل العام ضمن خطة موضوعة، ولا مساعدة المواطنين في تسهيل تنقلاتهم من خلال دعم أسعار المحروقات أو تخفيض سعر التعرفة، فجاءت ظاهرة "الفانات" التي ولدت بشكل عشوائي، فاستطاع المواطن التنقل عبرها بأسعار أقل من السرفيس أو التاكسي، وجنب أعصابه التوتر الناجم عن القيادة في زحمة لا تطاق. لكن أزمة السير الخانقة لم تُحَل، فلا محطات لنقل الركاب بل يتوقف الباص أو الفان حيث يتواجد الراكب ولو كان في منتصف الطريق، أو على قارعة الرصيف، أو عند باب مبنى أو دكان أو عند مدخل زاروب صغير، لتأتي ردود الفعل زمامير السيارات خلفها، وصراخاً وشتائم وسباباً، وأحياناً تعاركٌ وتقاتل وتصادم، ويربح المعركة من يحمل هاتفاً يحوي أرقاماً لأصحاب النفوذ.
ومن أراد الهروب من ثمن السرفيس أو الفان وزحمة السير الخانقة، يختار الدراجة النارية حلاً، يتنقل فيها من بيته إلى عمله، إلى نزهاته، وقد يكون تجواله وحيداً أو مع عائلته أو مع مجموعة من رفاقه وأترابه، ذهاباً وإياباً، بكراً وعشياً، عند دلوك الشمس إلى غسق الليل، وتكبر الحماسة وتشتعل المنافسة عند الانطلاق على عجلة واحدة، خصوصاً إذا كانت حبيبة القلب على شرفتها ترمقه بنظرات الدلال.
وكانت الموجة الجديدة القديمة التي سار في غمراتها اللبناني وخصوصاً مع بدء ما عُرف بالثورة منذ عام، وهي حرق الإطارات عند كل أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خدماتية، والغريب أن هذه الممارسة لم تقتصر على جماعة المعارضة للحكومة بل تعدتها إلى الجميع، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ومشاربهم وأحزابهم، ويكون القاسم المشترك غضباً يطال الحياة بكل أنواعها وتشعباتها، ويترجم على أرض الواقع والشارع سحب متلبدة تجتاح الفضاء والبيوت ولا يتضرر منها الزعماء وأصحاب القرار الذين تسببوا في آلام المواطنين، بل الذين أحرقوا الإطارات الجهنمية وجيرانهم الذين يعانون ما يعانون ويألمون كما يألمون، وإن خالفوهم في توجههم السياسي الاستراتيجي أو التكتيكي.
إن ما ذُكر ليس إلا صورة صغيرة لحياة تمتلئ بتفاصيل مضحكة إلى حد الاستهتار ومبكية إلى حد الجنون، فيها الكثير من الواقعية الشاحبة والكثير من الكاريكاتورية المزخرفة. شعب تملأه التناقضات في انفعالاته وسلوكياته وتوجهاته وما يرغب فيه وما يرغب عنه، تارة تصفه بالقوة والعزيمة والإرادة الصلبة التي تحطم كل الحواجز، فيخلق من الضعف قوة، ومن العدم وجوداً، ومن مشاكل الأيام حلولاً تناسب الحيِّز الضيق الذي يحتله في وجوده في هذا الوطن، وتارة تشعر أنه بائس مستكين يلعن الحياة والموت والحرب والزعامات، ويترقب فرجاً في نتيجة انتخابات هذه الدولة أو تلك، أو أملاً يفتح الطريق لهجرة إلى ما وراء البحار. إنه شعب يتهم زعماءه بالتقصير والقصور والفساد والإفساد والسرقة والخيانة والكذب والنفاق، لكنه عندما يأتي زمن الانتخابات يبارك الصناديق بانتخابهم، ويناضل بالمال والنفس ليرفعهم، وينسى أنه رسم بيده طريق المستقبل القاتم الشاحب المليء بالعثرات، ليعود مجدداً بلعنهم ولومهم وظلمهم بانتظار الانتخابات الجديدة التي لا تحمل جديداً. إنه شعب سرق زعماؤه سني عمره وأحلامه وآماله، وجاء الوقت ليستدرك أخيراً أن ما يملكه في المصارف من حفنة من الدولارات قد اضمحل إلى غير رجعة، وأن الجوع يرسم ملامحه أمامه، فلم يثُر ولم ينتفض ولم يقم الدنيا ويقعدها، لكنه وبكل ذكاء وحنكة وبعد نظر ينتظر بفارغ الصبر إلى ما سوف تؤول إليه الانتخابات الأميركية: بقاء ترامب أم انتصار بايدن…