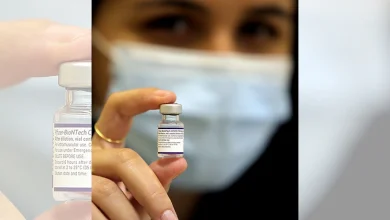الحوارنيوز – صحافة
تحت هذا العنوان كتب ماهر سلامة في صحيفة الأخبار يقول:
ما يحدث الآن في سوريا هو تسريع ما كان يقوم به نظام البعث للوصول إلى حالة الانفتاح الكامل على الأسواق العالمية، بحيث يصبح رأس المال الغربي قادراً على دخول الاقتصاد السوري بشكل حرّ، وهو ما يسهم في ضرب السيادة الاقتصادية. وبتحوّل سوريا نحو الاقتصاد الحرّ، تكون كل البلدان العربية قد أصبحت جزءاً من منظومة المال العالمية، إلا الجزائر التي لا تزال تحافظ على جزء من الخصوصية لاقتصادها
لم تمضِ أيام على سقوط النظام في سوريا حتى بدأ الحديث عن الشكل الاقتصادي للنظام الجديد. وانتشر تسجيل صوتي لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، لؤي المنجد، موجّه إلى التجّار وأصحاب الرساميل، يقول فيه إن سوريا ستتحوّل نحو اقتصاد «السوق الحرّة التنافسية». «يُبشّرهم» المنجد بأن حلمهم بنهاية الاقتصاد الموجّه وفتح الحدود بشكل كامل سيتحقق مع الحكومة الجديدة ليصبح مماثلاً لما هو في لبنان ودبي وتركيا.
خطيئة النظام
هذا المسار لم يبدأ اليوم، بل بدأت خطواته تظهر بوضوح في مطلع عام 2010 بعد عقود من تسلسل الليبرالية إلى سوريا. ففي بداية فترة حكم بشار الأسد، تقرّر الانتقال المباشر نحو ما سمّي «اقتصاد السوق الاجتماعي». وأدّى ذلك إلى ظهور نخب سياسية وتجارية، مرهونة برأس المال الغربي، مع تسهيل دخول الرساميل، وأبرزها الخليجية، إلى الاقتصاد السوري تحت عنوان الاستثمارات التي تشاركت مع هذه النخب السياسية والتجارية. وبحسب ما ورد في كتاب الباحثَين: علي القادري وليندا مطر «سوريا: من الاستقلال الوطني إلى الحرب بالوكالة»، فإن «الدولة السورية لم تبدأ بتقنين مواردها العامة وإنفاقها على الرعاية الاجتماعية بشكل جدي، إلا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين». وبحلول نهاية العقد المذكور، كانت الدولة قد «وضعت معظم ثرواتها المالية والحقيقية عند أقدام القطاع الخاص. وكانت آليات تخصيص الموارد تتبع المصالح والأهواء الشخصية».
لم يحصل هذا الأمر دفعة واحدة. فقد كان نظام حزب البعث يبحث عن طريق للدخول إلى الاقتصاد العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان داعماً أساسياً على صعيد التنمية والتسلّح وتصريف المنتجات. «ولم تبدأ إصلاحات السوق إلا في أواخر الثمانينيات بمجرد سقوط الاتحاد السوفياتي» بحسب القادري ومطر. وليس مستغرباً، بحسب الباحثَين أن «الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الواسعة النطاق التي أدخلها بشار الأسد أدّت إلى تآكل حصّة دخل العمالة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الأول من عهده».
في عامَي 2006 و2007 ألغت الحكومة السورية القيود المفروضة على أسعار السلع الضرورية ورفعت الدعم عن استهلاك السلع الأساسية وعن الإنتاج الصناعي القومي
عملياً، شكل النظام السياسي، وما فتحه من مجالات للاستفادة من مراكز السلطة والعلاقات بها، قد يكون سهّل استغلال فكرة إعطاء القوّة للقطاع الخاص، ما أدّى إلى توزيع غير متناسب للموارد. فمن مجمل التعديلات التي أدخلت في عهد بشار الأسد، ولا سيما التعديلات الجوهرية التي فرضها في عامَي 2006 – 2007، والتي كانت على شكل «علاج بالصدمة» وفق توصيف الباحثَين، أدّت إلى الغاء القيود المفروضة على أسعار السلع الضرورية، وسحبت الدعم عن حزم الاستهلاك الأساسية، وقلّصت من الإقراض المدعوم للتجارة وللإنتاج الصناعي.
قبل هذه التطورات، وتحديداً في مرحلة ما بعد عام 1964، كان النظام في سوريا يسعى إلى بناء التنمية من خلال الاعتماد على الذات أو الاشتراكية. استمرّ الأمر في الخمسينيات والستينيات، إلى أن تقرّر في بداية عهد حافظ الأسد «تخفيف الموقف الاشتراكي وصولاً إلى مرحلة ابنه بشار. وبحسب الباحثَين، مرّ الاقتصاد السوري بثلاث مراحل: التنمية الاشتراكية، تخفيفها وانتهاؤها بحلول أواخر عام 2010. فقد انهار النموذج الاقتصادي الذي كان يضمن في السابق الاحتياجات الأساسية للمجتمع من خلال القدرات والموارد المحلية.هكذا، تحوّلت سوريا إلى النموذج الذي يؤمن بأن الدافع الأساسي للاقتصاد هو القطاع الخاص. ويمكن التماس هذا السعي في التسجيل الصوتي لوزير التجارة السابق، الذي يظهر فيه «حلم» النخب الاقتصادية في سوريا بالتوجّه إلى الأسواق المفتوحة التي تعوّم القطاع الخاص.
ورغم تباطؤ معدّل نموّ الوافدين الجدد إلى سوق العمل، إلا أن معدّل خلق الوظائف «اللائقة» المصمّم على الطراز النيوليبرالي «انخفض بمعدل أسرع بكثير» وفق الباحثَين. وفي استجابة لانخفاض الطلب على الاستثمار والاستهلاك، انخفض الطلب على العمالة أيضاً. لكن ذلك لا يظهر بوضوح في الأرقام الرسمية التي ركّزت على «انخفاض معدّل البطالة». في النتيجة، وكما حدث في أماكن أخرى، أصبح عدد هائل من العمالة الزائدة عن الحاجة، والتي كانت تكافح من أجل كسب لقمة العيش في وظائف غير منظّمة فقيرة، يُعَدّ الآن من العمالة العاملة. يعود ذلك إلى ربط معدل البطالة الحقيقي بمستويات المعيشة «اللائقة». بهذه الطريقة، أصبح الوضع المعيشي أسوأ وأسوأ مع دخول الإصلاحات النيوليبرالية حيّز التنفيذ. وهناك أمثلة عديدة عن عائلات سورية كانت ترتكز على الزراعة، توجّهت إلى إغلاق مزارعها التي أصبحت من دون جدوى، والانتقال إلى مناطق المركز التي أصبحت تتركّز فيها الثروة بفعل سياسات الانفتاح وتمكين القطاع الخاص. هنا لعب عاملان دوراً مهماً؛ الأول، رفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات، وهو ما كان يخفّض الأكلاف على المزارعين ويسهم في خفض ربحيّتهم أو في خسارتهم. والثاني، يتعلق بتحويل الموارد إلى المدن التي أصبحت بؤراً لتركّز الثروة، بفعل تركّز القطاع الخاص فيها.
لذا يستنتج الباحثان «أن الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، سواء من خلال القمع، أو من خلال التدابير الإيديولوجية المنفّرة، تعمل على تهميش الاهتمامات العامة أو العمالية. كما تمارس ضغوطاً على حصّة الدخل المستحقة للطبقة العاملة». كما أن ارتفاع معدلات التضخم ساهم في إضعاف القدرة الشرائية للعمال، واتّساع الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي، وإهمال المناطق الريفية، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، في خلق الظروف الموضوعية للاضطرابات الاجتماعية في سوريا.
تحرير السوق أمام الرساميل والأفراد
ستصبح سوريا آخر دول المنطقة التي تخضع لضغوط منظومة الاقتصاد العالمي في ما يتعلّق بمعاييرها للدول التي تريد أن تكون جزءاً من هذه المنظومة. وهذه المعايير تتضمّن تحرير حركة رؤوس الأموال وتحرير الأسواق وعدم تدخّل الحكومات فيها. وتُشكّل هذه المعايير أُسس النظام الليبرالي وتذهب أبعد نحو النيوليبرالية التي تفرض إنهاء دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام من خلال عدّة إجراءات مثل الخصخصة والتقشّف في الإنفاق العام وسواها من الإجراءات.