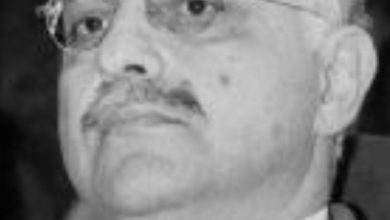حين يتكلم السياسيون ولا يفهمون على بعضهم: أزمة لغة أم أزمة وطن؟(أسامة مشيمش)

بقلم د. أسامة توفيق مشيمش – الحوارنيوز
في زمن الارتباك الوطني، لم نعد نبحث في كتب تعليم التحقق في المخطوطات من باب الترف الأكاديمي، بل لأننا أصبحنا فعلاً في حاجة إلى فك رموز ما يُقال على المنابر، وفي التصريحات، وفي جلسات الحوار التي فقدت طابعها التواصلي، وتحوّلت إلى مونولوجات متقاطعة، لا يربطها رابط سوى كونها تُقال بصوت عالٍ، وتُبثّ على الهواء مباشرة، ولا أحد يفهم على أحد.
لقد تحوّلت اللغة السياسية في وطننا إلى معضلة حقيقية، لا على مستوى الشكل فقط، بل على مستوى المضمون أيضًا. فحين يجتمع الساسة، لا يبدو أنهم يتحدثون اللغة نفسها، حتى وإن استخدموا المفردات ذاتها. أحدهم يقول “إصلاحاً”، فيفهمه الآخر “انقلابًا”، يقول هذا “تسوية”، ويرد عليه الآخر “خيانة”. وفي خضم هذه الثنائية الفارغة من الفهم، يغيب الفعل العقلاني، ويحلّ محله رد الفعل الغريزي، فيدفع المواطن الثمن: حيرة، شلل، واغتراب.
نعم، لقد أصبح المواطن تائهًا بين الكلمات، عاجزًا عن التقاط المعنى، متخبطًا في تحليل النوايا. لغة الساسة، بدلاً من أن تكون أداة توجيه، تحوّلت إلى لعبة مراوغة، يتقنها البعض لخلط الأوراق لا لتوضيحها، لإثارة الضباب لا لجلاء الرؤية.
ولعل الأخطر أن هذه اللغة المنفصلة عن الواقع قد انقطعت صلتها لا فقط بالعامة، بل حتى بين السياسيين أنفسهم. فكل منهم يعيش في قاموسه الخاص، بمفرداته الخاصة، بتعريفه الخاص للمصطلحات الكبرى: الدولة، الوطن، السيادة، المقاو.مة، العدالة، الإصلاح… حتى لم يعد الحوار ممكناً، بل صار حوار الطرشان بامتياز، حيث الكل يتكلم، والكل يصغي إلى صوته فقط.
وهنا تتداخل الأزمة اللغوية مع الأزمة السياسية، لتنتج وضعًا مشوهًا، تكون فيه الكلمات ذاتها، لا وسيلة تفاهم، بل أدوات تضليل. فإذا كان التواصل بين السياسيين أنفسهم معطّلاً، فكيف نتوقع من المواطن أن يفهم، أن يختار، أن يحكم، أن يشارك؟ كيف يُطلب منه أن يكون طرفاً فاعلاً، وهو لا يمتلك مفتاح اللغة التي تُدار بها شؤون بلاده؟
في هذا السياق، يبدو أن الإشكالية ليست فقط في اللغة العربية الفصحى التي لم تعد مفهومة في الخطاب السياسي، ولا في اللهجات المحلية التي تُستبعد من التداول الرسمي، ولا حتى في اللغات الأجنبية التي يستخدمها البعض لتجميل خطابه أو لإضفاء “بُعد دولي” عليه. بل تكمن الأزمة في غياب اللغة المشتركة، ذلك المعجم السياسي الوطني الذي يوحّد المعاني، ويوضّح المصطلحات، ويمنع الالتباس.
ولأن السياسة في جوهرها هي فنّ التفاهم، فإن غياب هذه اللغة المشتركة لا يعني فقط فشلًا في الأداء السياسي، بل تهديدًا مباشرًا لفكرة الوطن ذاته، الذي يقوم أصلاً على فهم مشترك للمصلحة، للهوية، وللمصير.
ومن هنا، نصل إلى سؤال جوهري قد يبدو غريبًا، لكنه مشروع: هل نحتاج إلى لغة جديدة؟
لغة سياسية وطنية، لا تعود مرهونة بتراث أيديولوجي معين، ولا محمّلة بتفسيرات متباينة، ولا قابلة للاختطاف أو التزوير. لغة بلا ماضٍ متشظٍّ، ولا استعارات فارغة، ولا ازدواجية في المعاني. لغة تُبنى من وجدان الناس، من معاناتهم، من أحلامهم الواضحة والبسيطة، وتُعاد من خلالها صياغة الخطاب العام بشكل يربط القول بالفعل، والوعد بالنتيجة.
لسنا بحاجة إلى مجرد أبجدية جديدة، بل إلى مشروع لغوي جامع، يردم الهوّة بين الحاكم والمحكوم، بين الخطيب والجمهور، بين القرار ونتيجته. مشروع يبدأ من إعادة تعريف الكلمات الأساسية في حياتنا السياسية: ما معنى الوطن؟ من هو المواطن؟ ما هي السيادة؟ ما هو الإصلاح؟ ما معنى العدل؟ ما هو العدو؟ وما هي آليات السلام؟
بدون لغة موحّدة، لا يمكن لسياسة أن تُفهم، ولا لقرارات أن تُقيّم، ولا لأزمات أن تُحل. وسيظل المواطن مستمعًا صامتًا، يُقال له “أنت المعنيّ”، بينما هو في الحقيقة، الغائب الأكبر.
قد يكون اقتراح لغة جديدة ضربًا من الخيال، لكنه خيال ضروري، في وطن لم يعد فيه للكلام معنى، ولا للحديث هدف، ولا للخطاب جمهور.