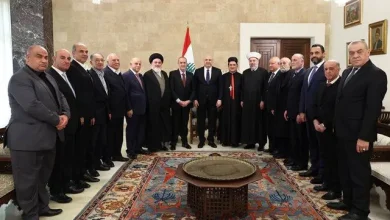الحوار نيوز – صحافة
تحت هذا العنوان كتب محمد نور الدين في صحيفة الأخبار:
من بروكسل إلى كييف، ومن الخليج إلى مصر، بدأت تركيا حملة تثبيت سياساتها التي كانت قد شرعت في انتهاجها منذ ما قبل انتخاب رجب طيب إردوغان رئيساً لولاية ثالثة. وخلال أقلّ من شهر، سيكون إردوغان على موعد مع محطّات مهمة في سياق تعزيز الديبلوماسية التركية وتوسيعها في الاتجاهات كافة. وليست زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإسطنبول أمس، ولقاؤه نظيره التركي، سوى بداية الحراك الخارجي المنتظَر لأنقرة. والواقع أن هذه الزيارة غير مفاجئة؛ فالعلاقات بين البلدين جيدة، وهما يتبادلان المواد الغذائية، فيما تبيع تركيا، أوكرانيا، المسيّرات التي كان لها دور مؤثّر في إلحاق خسائر بالقوات الروسية. مع ذلك، فإن أنقرة حرصت منذ اللحظة الأولى – وهو ما كان ولا يزال محلّ إجماع داخلي – على أن تكون على مسافة إيجابية من طرفَي الصراع؛ ولذا، وبينما واصلت دعم كييف بالأسلحة، وقفت ضدّ فرض الحظر الاقتصادي على موسكو، وسعت للقيام بأدوار وساطة في أكثر من ملفّ، من مثل استضافة مسؤولين من البلدين في بداية الحرب، كما نجحت في إقناع الطرفَين باتفاقية مرور الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بموافقة روسيا وتحت رقابة تركيا، إلى العالم، وهي اتفاقية كان لها دور مهمّ في الحدّ من ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً، وفي توفيرها أصلاً، بينما مثّلت تركيا وسيطاً في تبادل الأسرى بين البلدين أكثر من مرّة. ولا تخرج زيارة زيلينسكي عمّا يشغل أوكرانيا من احتمال تعليق الاتفاقية المُشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في 17 تموز الجاري، بعدما أعلنت روسيا أنها ليست في صدد تمديدها، ما من شأنه أن يحرم أوكرانيا من مصادر مالية كثيرة. لكن الأكيد أن إردوغان سيضع ثقله لدى صديقه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتجديد العمل بالاتفاقية، ولو مع بعض التعديلات، لأن في ذلك زيادة في «الوزن» التركي الدولي.
أمّا الموقف التركي من عضوية السويد في «حلف شمال الأطلسي»، فلا يزال متمنّعاً نسبياً، متراوحاً بين معارض لأسباب تتصل بدعم استوكهولم لنشاطات «حزب العمال الكردستاني» وجماعة فتح الله غولين، وآخر معترف بأن السويد حقّقت تقدّماً عبر إقرارها كلّ ما تريده تركيا من تشريعات في البرلمان، ولكنه يطالب بالتأكد من أن الأولى ستلتزم بترجمة تقدّمها على أرض الواقع، وخصوصاً أن التعهّدات النظرية هي الأسهل بالنسبة إلى أيّ دولة، وأنه لا يمكن في حال امتناع استوكهولم عن الالتزام بتلك التعهّدات، أن يعاد طردها من الحلف. والجدير ذكره، هنا، أن عدداً كبيراً من دول «الأطلسي» يمنح دعماً مادياً لـ«الكردستاني»، ويسمح للحزب ومؤيّديه بالتحرّك بحرية تحت مسمّيات مباشرة وغير مباشرة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا واليونان، فيما لا تجد تركيا سبيلاً إلى أيّ خطوة تحول دون ذلك. وعلى رغم ما تَقدّم، فإن إجماع الدول «الأطلسية» على أن السويد أوفت بالتزاماتها – نظرياً -، واعتراف تركيا بهذا الواقع، وضعا الأخيرة في موقف حرج جدّاً، وهو ما يعني أن التأخير في الموافقة على العضوية، ربّما مردّه محاولة تجيير «فضل» الموافقة إلى إردوغان شخصياً، عندما يلتقي الرئيس التركي، الاثنين المقبل، الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، عشية القمة الحاسمة لزعماء الحلف، والتي ستنعقد يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا. وعندذاك، سيتّضح ما إذا كانت تركيا رضخت بالمجّان للضغوط «الأطلسية» عليها، أو أنها نالت في المقابل موافقة أميركية، ولو متأخرة، على تصديق الكونغرس على قرار تحديث طائراتها من طراز «أف – 16».
عودة تبادل السفراء بين مصر وتركيا أخيراً، مثّلت خطوة مهمّة على طريق طيّ صفحة النزاع
أمّا الملفّ الثالث، الذي يعكس استمرار جهود تركيا لضبط علاقاتها مع الخارج، فهو اتفاقها مع مصر قبل أيام على تبادل السفراء بينهما، بعد قرابة تسع سنوات من قطع علاقاتهما الديبلوماسية في عام 2014، إثر إطاحة حكم الرئيس «الإخواني» الراحل محمد مرسي، والانتخاب اللاحق لعبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية المصرية. منذ ذلك التاريخ، دخلت العلاقات في مرحلة توتر شديد، تبادل مسؤولو البلدَين في خلالها النعوت القاسية؛ إذ وصف إردوغان السيسي بـ«القاتل» و«الانقلابي» وما شابه، وصولاً إلى رفض الرئيس التركي أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2014، الجلوس إلى طاولة الغداء نفسها حيث كان يجلس نظيره المصري. وفاقم من التوتّر بين البلدَين، التدخّل التركي العسكري المباشر في الحديقة الخلفية لمصر، أي في ليبيا، ومن ثمّ ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية بين أنقرة وحكومة طرابلس التي كان يرأسها فايز السراج. وظَهر نتيجة هذه الخلافات، كما الخلاف بين تركيا وكلّ من السعودية والإمارات، وبين دول الخليج وقطر عام 2017، ما يشبه «البلوك» المتشكّل من مصر ودول الخليج واليونان وقبرص اليونانية، في مواجهة تركيا وقطر.
لكن عودة تبادل السفراء بين البلدين أخيراً، مثّلت خطوة مهمّة على طريق طيّ صفحة النزاع، وخصوصاً أنه أعقبها الإعلان عن خطوة أهمّ، وهي زيارة السيسي «التاريخية» المرتقبة لتركيا في 27 تموز الجاري. وستمثّل هذه الزيارة، التي تأتي بعد مصافحة أولى بين إردوغان والسيسي على هامش مونديال قطر، مناسبة مهمّة لتنقية العلاقات ممّا تبقّى فيها من شوائب، والبحث عن حلول للمشكلات التي لا تزال عالقة، من الوضع في ليبيا، إلى نشاط «الإخوان المسلمون» ولا سيما الإعلامي في تركيا، إلى الوضع في شرق المتوسط على صعيد الطاقة، بما يشمل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وستلي زيارة السيسي لأنقرة، جولةٌ لإردوغان على ثلاث دول خليجية هي: السعودية والإمارات وقطر، وُصفت بأنها أولاً لشكر تلك الدول على الدعم الكبير الذي قدّمته خلال الحملة الانتخابية لدعم الليرة التركية، وبالتالي دعم فرص إردوغان في الفوز بالرئاسة، علماً أن الأموال المُشار إليها قُدّرت بما لا يقلّ عن خمسين مليار دولار. أمّا الهدف الثاني منها، فهو محاولة تحصيل مزيد من الأموال من البلدان الخليجية لحساب برنامج الحكومة الاقتصادي الجديد، فيما الهدف الثالث، نيل الدعم التمويلي اللازم أيضاً للتحضير للانتخابات البلدية في آذار المقبل، في ظلّ تصميم إردوغان على استعادة بلديتَي إسطنبول وأنقرة من يد المعارضة، وهو ما يقول مسؤول تركي لم يعلَن عن اسمه، إن الرئيس يتطلّع من أجله إلى جمع ما لا يقلّ عن 25 مليار دولار. وتأتي الجولة المرتقبة بعد أسبوعين تقريباً على زيارة للإمارات قام بها وزير المال، محمد شيمشيك، ونائب رئيس الجمهورية، جودت يلماز، لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، ولا سيما زيادة الاستثمارات الإماراتية في تركيا. والجدير ذكره، هنا، أنه لا يمكن وضع العلاقات مع الدول الخليجية الثلاث في كفّة واحدة؛ فهي في ما يتّصل بالسعودية والإمارات تندرج في إطار «استعادة العافية»، وبلورة آفاق التعاون الجديد الثنائي كما على الصعيد الإقليمي، بينما مع قطر تتّسم بطابعها الاستراتيجي في كلّ الميادين.
وفي خضمّ كلّ هذه الحركة التركية الواسعة على صعيد السياسة الخارجية، والتي تسعى لتكريس خيارات بدأت قبل الانتخابات الرئاسية في 28 أيار الماضي، فإن التساؤل الأكبر سيبقى قائماً حول التعثر الذي يواجه تقدم مساعي المصالحة بين تركيا وسوريا.