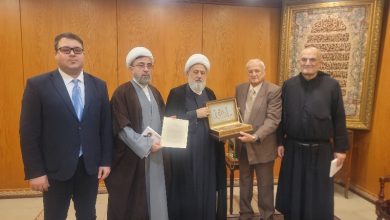الجامعة اللبنانية تحت العنف الرمزي: تمييز عنصري بــاسم المناصفة ( عبد الله محي الدين)

الحوارنيوز – صحافة
تحت هذا العنوان كتب عبد الله محي الدين* في صحيفة الأخبار:
أثار إعلان مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 4 كانون الأول 2025 موافقتَه على آلية تفريغ 1282 أستاذاً متعاقداً بالساعة في الجامعة اللبنانية، وفق معايير عرضتها وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، جدلاً طائفياً واسعاً. وقد توزع الأساتذة بحسب الانتماء الطائفي بنسبة 40% شيعة، 29.4% مسيحيين، 25.8% سنّة، 4.2% دروزاً، 0.1% علويين و0.5% غير محددي الانتماء. مع اقتراح تنفيذ التفرغ دفعة واحدة أو على عدة مراحل وفق توفر التمويل.
ويأتي هذا القرار في سياق أزمة بنيوية تعانيها الجامعة اللبنانية، بعد تقاعد 1113 أستاذاً منذ عام 2014، الأمر الذي أدّى إلى إفراغها من الأساتذة المتفرغين وأساتذة الملاك، ورفع نسبة ساعات التدريس المسندة إلى المتعاقدين بالساعة إلى نحو 68%، في حين ينصّ قانون الجامعة على ألا تتجاوز النسبة 20%. كما ترافق ذلك مع تراجع حصّة الجامعة اللبنانية من طلاب التعليم العالي من 50.4% إلى 29.6%، أي بتراجع بلغ 20.8% لصالح الجامعات الخاصة ولا سيما تلك التي تتبع للقوى السياسية الطائفية.
وبعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء، برزت اعتراضات قادتها أحزاب ومؤسسات مسيحية، وفي مقدمتها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إلى جانب الرابطة المارونية ولابورا، مطالبين بما سمّوه المناصفة الطائفية، ومشككين في المعايير المعتمدة، معلنين أنهم لن يقبلوا بأي تفرغ لا يحقق التوازن ويحفظ حقوق الأساتذة الذين تركوا (تخلّوا عن) الجامعة خلال الأزمة، واستخدموا عبارات مهينة للأساتذة والجامعة معاً، وذهب الأب طوني خضرا إلى وصف الجامعة اللبنانية بأنها «جامعة شيعية»، مطالباً بتعديل قانون التفرغ رقم 66 كي يُسمح بإدخال 250 أستاذاً مسيحياً من خارج لبنان.
كما صدرت مواقف من قبل بعض الشخصيات النيابية والروحية السنّية التي طالبت رئيس الحكومة بعدم إقرار الملف قبل دراسته دراسة شاملة وإعلان الأسماء، وأن تكون حصّة السنّة مماثلة لحصة الشيعة، من دون الاعتراض على المطالبة بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في موقف يشير إلى قبولها ضمناً.
يُظهر تحليل مجمل المواقف أن الاعتراضات ليست أكاديمية أو تقنية، بل سياسية -طائفية، ترفض اعتماد معايير خارج منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية. إذ إن المعايير المعتمدة أسّست، وللمرة الأولى، لمبدأ المساواة بين الأساتذة المتعاقدين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، ما دفع القوى المعترضة (قبيل الانتخابات النيابية في أيار 2026) إلى المطالبة بملف يحقق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وأن يتقاسم الشيعة والسنّة والدروز حصّة المسلمين.
وسيتطلب تحقيق هذه المعادلة تعديل التوزيع الطائفي في الملف من خلال:
• شطب 213 اسماً لأساتذة شيعة من ملف التفرغ.
• شطب 31 اسماً لأساتذة من السنة.
• زيادة أعداد الأساتذة المسيحيين بما لا يقل عن 213 أستاذاً، وبما يتجاوز العدد الموجود حالياً في الجامعة.
لمن لا يعرف، إنّ تفريغ أساتذة مسيحيين لم يسبق لهم التعاقد مع الجامعة اللبنانية يعدّ خرقاً لقانون التفرّغ وشروطه المنصوص عليها في القانون الرقم 66. كما إنه خرق للدستور اللبناني الذي لا يحتمل التأويل، حيث ينصّ على أنّ المناصفة تُطبّق حصراً على وظائف الفئة الأولى، بينما تُدار بقية الفئات، ومن ضمنهم أساتذة الجامعة، وفق مبدأي الجدارة والاختصاص.
يكشف التدقيق في المضمون الفعلي لهذا الموقف عن تناقض بنيوي في الخطاب الطائفي اللبناني، يقوم على تقسيم اللبنانيين إلى جماعات غير متساوية في الإدارة والمشاركة في الدولة، من خلال حصص تفاوضية جماعية لا حقوق مواطنية فردية، تُقدّم بصيغة ثنائية تبسيطية (مسيحيون/ مسلمون)، ويعمد إلى تقسيم المسلمين، الذين يُفترض أنهم غير متساوين مع المسيحيين في البنية السياسية العامة، إلى طوائف متساوية (سنة/شيعة) في ما بينها داخل هذا اللامتكافئ البنيوي، ويجري تبرير منطق المتناقض بنيوياً من خلال سمات «مُثقلة» بالانتماءات الطائفية والمذهبية.
تُفضي هذه المقاربة إلى إنتاج مفهوم خاص للتمييز، يقصي معايير الكفاءة والجدارة الفردية لصالح سمات جماعية، إذ تُهمّش حقوق الأفراد، وتخضع لمبدأ أولوية «حقوق الجماعات». وبهذا المعنى، لا يعود للفرد قيمة قائمة بذاتها في النظام السياسي-المؤسساتي، بل كحصص تفاوضية بين جماعات متمايزة.
ويقوم هذا الشكل من التمييز في لبنان على تصنيف الطوائف ضمن هرمية رمزية-سياسية غير معلنة تُقسم فيها الجماعات إلى:
• الطوائف «المكوّنة» للبنان والتي تمتلك حقوقاً تأسيسية تميزها عن باقي الطوائف.
• الطوائف «المُهدّدة» والتي يُبرر لها امتيازات حمائية باسم الهواجس الوجودية.
• الطوائف «النوعية» التي تُقدّم باعتبارها متفوقة ثقافياً أو مؤسساتياً على طوائف «كمية».
• الطوائف «المُهدِدة» وينظر إلى وزنها العددي كخطر يجب ضبطه.
• الطوائف «الخاضعة» التي تقبل تفوّق طوائف وتطالب بالمساواة مع طوائف أخرى.
يسهم هذا التصنيف بين اللبنانيين في إنتاج نظام حكم مبني على التمييز الرمزي والمؤسساتي، لأنه يحوّل الدولة والمؤسسات العامة إلى مساحة لتوزيع «المغانم»، ويُنتج خوفاً دائماً ومتبادلاً بين الطوائف، ويُقصي منطق المواطنة لصالح منطق الانتماء الطائفي والمذهبي، كما يعزز سلطة الزعامات الطائفية بوصفها الممثل الحصري لـ«حقوق الطائفة». وبهذا لا يعاد إنتاج التمييز فحسب، بل يعاد إنتاج النظام الطائفي عبر آليات تبدو قانونية أو توافقية، فيما هي في جوهرها نفي لحقوق الأفراد وتقويض لإمكان قيام دولة تقوم على المساواة والمواطنية.
يُظهر تحليل مجمل المواقف أن الاعتراضات ليست أكاديمية أو تقنية، بل سياسية -طائفية، ترفض اعتماد معايير خارج منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية. إذ إن المعايير المعتمدة أسّست، وللمرة الأولى، لمبدأ المساواة
تنطلق الممارسة التمييزية في لبنان من خطاب يركز على المناصفة، تحت عناوين تبدو في ظاهرها حمائية، وتهدف إلى تأمين «حقوق الطوائف» وهواجسها الوجودية. غير أنّها، وفقاً لمقاربة عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو، تُشكّل نموذجاً واضحاً لـلعنف الرمزي، إذ يُقدّم التمييز بين اللبنانيين بوصفه منطقاً طبيعياً ومقبولاً، بل وضرورياً، في ظل البنية الطائفية للنظام السياسي. ويتحوّل هذا العنف إلى تمييز مؤسساتي يُمارَس عملياً من خلال تكريس أعراف غير دستورية، أبرزها اعتماد المناصفة في وظائف ما دون الفئة الأولى، وعبر آليات توظيف تُقصي مواطنين مستحقين من حقهم في الوظيفة العامة بحجة «اكتمال حصة» الجماعة الطائفية التي يُصنَّفون ضمنها.
وفي المقابل، يجري استقدام أشخاص من جماعة محددة، قد لا تتوافر فيهم شروط الكفاءة أو المعايير القانونية نفسها التي يتمتع بها مَن حُرموا من الوظيفة، أو يتم ذلك في خرق صريح للقوانين المرعيّة الإجراء. ويتعزّز هذا النمط من التمييز المؤسساتي عندما يُصرّ على تطبيق المناصفة بين جماعات غير متناسبة عددياً، إذ تُعادل حصة الفرد المنتمي إلى طائفة أقل عدداً حصة فردين من الطائفة الأكثر عدداً، وفي حال عدم توافر العدد «المطلوب» من الطائفة الأقل عدداً، يُصار إلى حرمان جزء من أبناء الطائفة الأكثر عدداً من التوظيف، استجابة لمنطق التوازن الطائفي. وهكذا، يُعاد إنتاج نظام يُفرغ مبدأ المواطنة من مضمونه، ويُخضع الحقوق الفردية لمنطق المحاصصة الجماعية، في انتهاك صريح لمبدأ المساواة أمام القانون.
لا تُنتج هذه المقاربة التي تدّعي معالجة الاختلال الديموغرافي بين الجماعات حقوقاً فعلية، بل تُفرغ الإنسان من قيمته الذاتية ما لم يُقابَل بوجود «آخر» طائفي موازٍ، فنكون أمام منطق سلطوي يعيد تعريف الإنسان لا بوصفه كائناً حقوقياً مستقلاً، بل كوحدة عددية نسبية داخل معادلة توازن مصطنعة. فالفرد المنتمي إلى الجماعة الأكثر عدداً لا يُعترف به كقيمة إنسانية قائمة بذاتها، ولا كحامل لحقوق متساوية، بل يختزل إلى «زيادة» أو «فائض» فاقدٍ للقيمة الإنسانية والحقوقية والسياسية، ولا يكتفي هذا المنطق بإقصاء الإنسان، بل يُشيّئه، ويحوّله إلى أداة لضبط التوازنات، إذ تصبح المساواة مشروطة، والحقوق نسبية، والكرامة قابلة للتعليق باسم الحفاظ على الصيغة، أو «الشراكة الوطنية». وبهذا المعنى، لا يعود النظام السياسي معنياً بتنظيم التعددية، بل بإدارة عدم المساواة، عبر نزع القيمة الجوهرية عن الإنسان وإعادة توزيعها وفق اعتبارات طائفية لا إنسانية ولا أخلاقية ولا سياسية ولا دستورية.
تعبّر هذه الممارسة عن مفهوم العنف الرمزي عند بيار بورديو، حيث لا يُمارس الإقصاء عبر القهر المباشر، بل من خلال فرض آلية رمزية تجعل المقهور يتقبّل موقعه كأمر طبيعي أو «واقعي». فحين يقتنع الإنسان بأن قيمته مرهونة بوجود «نظير طائفي» له، يصبح هذا الإلغاء الذاتي نتيجة داخلية لمنطق مهيمن، لا مجرد ظلم خارجي. أمّا عند المفكر النقدي أنطونيو غرامشي، فإن هذا النموذج يندرج ضمن آليات الهيمنة التي لا تقوم فقط على القوة، بل على إنتاج قبول قسري جماعي بفكرة أن التمييز شرط للاستقرار، وأن نزع القيمة عن الأكثرية هو ثمن عدم تهديد «الوحدة الوطنية» الهشة بين الطوائف. هنا تتحوّل الهيمنة الطائفية إلى عقلٍ عام، ويُعاد إنتاج اللامساواة بوصفها ضرورة تاريخية، لا خياراً سياسياً قابلاً للنقاش.
ولا تقتصر ممارسة هذه المقاربة على الوظائف التي تُعدّ نوعية أو ذات طابع أكاديمي، كوظائف أساتذة الجامعة اللبنانية، بل تمتدّ لتشمل أيضاً وظائف إدارية دنيا من الفئة الرابعة (مثل حراس الأحراج) ما يكشف طابعها البنيوي لا الاستثنائي. كما يُظهر ذلك كيف يتحوّل هذا الخطاب إلى أداة إقصاء مؤسساتية ممنهجة، تُفرغ مبدأ الكفاءة والاستحقاق من مضمونه، وتُخضع حتى أدنى مراتب الوظيفة العامة لمنطق المحاصصة الطائفية.
أمّا من منظور الدستور اللبناني، فتُصنّف هذه الممارسة باعتبارها شكلاً واضحاً من التمييز بين المواطنين اللبنانيين على أساس انتمائهم الديني، في حين تُقدّم من منظور الممارسة السياسية للنظام السياسي الطائفي باعتبارها حماية للحقوق الطائفية وللمصلحة الوطنية. فالتمييز العنصري ينطلق من تصنيف الناس وفق هوياتهم الأولية (العرق والدين)، ويخالف مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون. بينما يقوم «التوازن الطائفي» على اعتبار الحقوق امتيازاً جماعياً لا فردياً، يهدف إلى ضمان موقع مميّز لفئة محددة في السلطة، ويتيح لها ممارسة عنف رمزي تجاه الجماعات الأخرى يتحوّل تدريجياً إلى تمييز عنصري مُلطف.
يُظهر الجدل الذي أُثير أخيراً حول ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، ولا سيما الخطاب الصادر عن الجهات المعترِضة، بنية متماسكة من العنف الرمزي والتمييز العنصري يمكن تحديدها من خلال مستويات مترابطة:
- يتمثّل المستوى الأول في عنف استعلائي مباشر، يتجلّى في تعابير تنزع الشرعية الأكاديمية عن الأساتذة، مثل: «الحشو»، «تفرّغ مشوّه لا يراعي الكفاءة»، «لا يتقنون اللغات الأجنبية»، أو توصيف الجامعة اللبنانية بأنها «جامعة شيعية». هذا الخطاب لا يناقش المعايير أو القوانين، بل يصدر حكماً قيمياً مسبقاً يربط الكفاءة بالانتماء الطائفي.
- أمّا المستوى الثاني، فيأخذ شكل خطاب تبريري باسم الهواجس، من خلال مفردات مثل: «عدم مراعاة المناصفة أو التوازن الطائفي»، «غياب الشراكة الوطنية»، أو «تهميش المكوّن المسيحي». هنا يُعاد إنتاج التمييز بلغة تبدو محايدة ومشروعة، لكنها في الواقع تحوّل المساواة القانونية إلى إشكالية، وتستبدل مفهوم العدالة بحقوق جماعية تفاوضية، بما يشكّل عنفاً رمزياً مقنّعاً.
- ويبرز المستوى الثالث في خطاب المظلومية، عبر ادعاءات غير صحيحة تُستخدم للضغط من أجل إعادة ترتيب المعايير، مثل: «المسيحيون لا يدخلون سوى إلى الفروع الثانية»، «عدم حفظ حقوق أساتذة خارج لبنان»، أو المطالبة بتعديل القوانين التي لا تسمح بتفريغهم. في هذا السياق، تُستخدم المظلومية كأداة ضغط لإعادة ترتيب المعايير، إذ تتحول القواعد القانونية والأكاديمية من أدوات مساواة إلى آليات إقصاء انتقائي، ويُستدعى القانون بصورة مجتزأة لتبرير خرقه.
- أمّا المستوى الرابع، الذي يصعب إيجاد توصيف له، فيتجلّى في الاعتراف الضمني بعدم المساواة مع «المسيحي»، والتشدد في مطالبة بالمساواة مع «الشيعي»، بما يكشف أن جوهر الخطاب ليس العدالة، بل إعادة توزيع الامتيازات داخل منطق المحاصصة.
لا تعبّر هذه المستويات الأربعة عن خلاف تقني أو إداري حول ملف التفرّغ، بل عن نظام متكامل من عنف رمزي، يُعيد إنتاج الهرمية الطائفية داخل مؤسسة أكاديمية يُفترض أن تقوم على الجدارة والكفاءة ويحوّل إلى تمييز عنصري بين الجماعات اللبنانية، ويقوم على أساس ثقافي-هويّاتي-جماعي، ويُمارَس بلغة «الحقوق» و«التوازن» و«الشراكة»، ويقوّض الأسس الدستورية للمواطنة المتساوية.
* أستاذ في معهد العلوم الاجتماعية – الجامعة اللبنانية