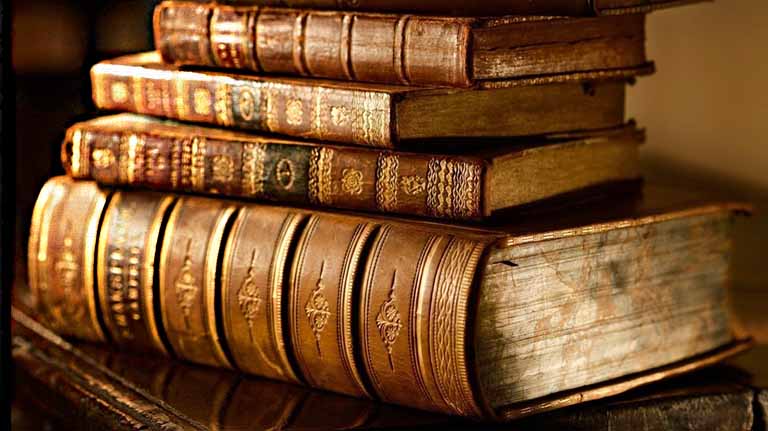
د. عدنان عويّد* – الحوار نيوز

هناك فرق كبير بين فهمنا للتراث واستلهامه وفق المنظور التاريخي*، حيث استقر التراث في عقولنا وعشعش فيها (بَعُجْرِهِ وَبُجْرِهِ)، وحولها – أي العقول – إلى سجون مليئة بالفتن، والتكفير، والقتل، والكراهية للمختلف، والاستبداد والتخلف، ورفض للجديد، والأهم السماح لسيطرة الخرافات والأساطير إضافة إلى تحكم دين الطقوس بدفه ومزماره، وفقه الحيض والنفاس والنقل لا العقل، ودين السلطات المستبدة ومشايخ السلطان، ودين الفرقة الناجيّة المشبع أيضاً بالصراع والكراهية ممثلاً بمرجعياته الطائفيّة والمذهبيّة والعقيديّة وغير ذلك، وهنا في هذا التاريخ الذي احتل عقولنا لمئات السنين، يتجسد تاريخ تخلفنا وضياعنا وغربتنا الروحيّة والاجتماعيّة، وتاريخ ضعفنا واستعمارنا من قبل الغير، رغم وجود الكثير من الجوانب المنيرة التي تم إقصاءها أو السكوت عنها.
وبين فهمنا للتاريخ واستلهامه وفق الرؤية التاريخانيّة * عندما نعمل على إدخال عقولنا ذاتها في كل هذا التراث وتحليله وإعادة تركيبه بعد فرز وإقصاء كل ما يعيق حركة العقل وتقدمه ومكانته في حياة الإنسان، وبالتالي العمل على تخليص هذا التراث من كل تلك السجون الموبوءة والمفخخة بالسوء الذي ذكرناها أعلاه، أي تخليصه من كل ما يساهم في تفتيت المجتمع وإضعافه وتخلفه، وليؤسس فيه كل ما هو عقلاني وتنويري.. وكل ما يؤمن بالإنسان ودوره وإرادته في تحقيق مصيره.. وأن يبحت ويجذر أيضاً الإيمان بكل ما هو قابل للتجديد والتطور والتبدل .. وعن كل ما يؤمن بالآخر ورأيه.. أي أن يبحث فيه عن الإنسان ذاته كقيمة كبرى في هذه الحياة.
إن مشكلتنا نحن العرب مع التراث لإسلاميّ بشكل عام، والنص المقدس منه (قرآن والحديث) بشكل خاص، ابتدأت بعد وفاة الرسول عمليّاً، وذلك من خلال الصراع على الخلافة بين المهاجرين والأنصار، وتوظيف حديث (نسبوه) للرسول يقول: (الخلافة في قريش)، ثم راحت المشاكل تتفاقم عبر تاريخ الخلافة من خلال تفسير النص وتأويله فيما بعد، أو وضع الأحاديث على لسان الرسول، وخاصة في الاتجاه السياسي وما يخدم السلطان أو معارضيه، حيث فُتح المجال واسعاً في تأويل النص القرآني وتفسيره، وفي وضع مئات آلاف الأحاديث كما تذكر مصادر الحديث وعلومه. هذا في الوقت الذي راح فيه تأويل النص المقدس وتفسيره من قبل أئمة الفقه وعلم الكلام، ينالهما التقديس أيضاً من قبل المتلقين من عامة الناس. أي إن شأن ما نال التفسير والتأويل من قبل مشايخ الدين في القرون الهجريّة الثلاث الأولى من التقديس شأن ما نال النص القرآني ذاته والحديث من تقديس. حيث لم يعد ما تم تأويله وتفسيره يقبل إعادة التفسير أو التأويل ولا يقبل التبديل أو التعديل أو حتى المراجعة إلى اليوم.
لا شك أن الرسول كان يدرك أن القرآن حمال أوجه وهو القائل: (القرآن ذلول حمّال أوجه فخذوه على وجهه الحسن)، كونه يدرك دلالة الآية السابعة من آل عمران التي تقول: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ). فالآية واضحة في دلالاتها المعرفيّة من جهة، وبالحوامل الاجتماعيّة لها ممن في قلوبهم زيغ، الذين سيوظفون هذا النص لمصالحهم ومصالح أسيادهم من جهة ثانية. لذلك على أساس هذه المواقف المعرفيّة والسلوكيّة، جاءت تلك الصراعات الفكريّة والسياسيّة التي كلفت الدولة والمجتمع منذ السقيفة حتى اليوم الكثير من الدماء، والتي لعبت على وترها السياسة، تحت مظلة تفسير النص الدينيّ وتأويله خدمة لأجندات كثيرة، أدت إلى انقسام المجتمع العربيّ الإسلاميّ إلى ثلاث وسبعين فرقة كل فرقة تقول هي الفرقة الناجية.
إن من يتابع المسيرة الفكريّة للخطاب الإسلامي من السقيفة إلى اليوم، يجد تلك التناقضات والخلافات على مستوى علم الكلام والفقه، فعلى مستوى علم الكلام، كان هناك المعتزلة وخطابهم العقلانيّ الذي يجل العقل وحريّة الإرادة في تقرير الإنسان لمصيره، وقد اتكأ عليه العقلانيون التنويريون الذين يهمهم الدين بروحه العقلانيّة ومصالح الناس، وهناك المناوئون للسلطة الحاكمة المستبدة وهم الذين روجوا بأن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وأن السلطات الحاكمة يجب أن تحاسب على أخطائها، لكونها – أي الأخطاء – هم من فعلها. وكان هناك الفكر الجبريّ أيضاً ممثل فكريّاً بالأشاعرة والماتريديّة، وفقهيّاً ممثلاً بالتيار الحنبليّ الذين اتكأت عليهم السلطة الحاكمة بعد فرمان المتوكل عام 232هـ الذي أمر باتباع النقل وترك العقل، واعتبار الحديث الضعيف أهم من الرأي كما يقول “ابن حنبل”، وراحت السلطات الحاكمة ومشايخها عبر هذا التيار الجبري يسوقون للرعيّة بأن سلطة القوى الحاكمة مقدرة من قبل الله، وما على الرعيّة إلا الطاعة والرضوخ لإرادة الله، وكل من يخرج على السلطات الظالمة سيخرج بالضرورة على ما قدره الله له، حتى ولو كان الحاكم فاسقا وفاسدا. وعلى هذا الصراع الفكريّ المستند أصلاً على النص المقدس المفسر والمؤول من قبل التيار القدري والتيار الجبري كما أشرنا أعلاه، توقف عليه أيضاً الموقف الفقهيّ ذاته، وظهور المدارس الفقهيّة كالشافعيّة والمالكيّة والحنبليّة والحنفيّة وبقية المذاهب الأخرى كالظاهريّة وغيرها من المذاهب التي لم يعد الاعتماد عليها فقهيّاً قائماً، والتي وصلت إلى أحد عشر مذاهباً، علماً أن المذهب الحنفيّ من المذاهب الأربعة المتبقية الذي أخذ بالرأي، إلا أن بقية المذاهب الأخرى المغرقة بالجبر قد حاربت أصحاب هذا المذهب ذاته، في الوقت الذي قامت السلطات الحاكمة ذاتها في سجن وتعذيب وإهانة كرامة كل من رفض التعاون مع هذه السلطات المستبدة والافتاء لمصالحها كما جرى لابن مالك وابن حنبل والشافعي ذاته، وكذلك ابن الحنفيّة كونهم رفضوا الافتاء بما يخدم مصالح السلطان، رغم أن المذهب الحنفي غالباً ما تعتمد عليه السلطات الحاكمة لتمرير مشاريع تصب في خدمة سير الدولة ومصالحها، متجاهلة مواقف المذاهب الجبريّة الداعمة لها، كما جرى في مصر في نهاية القرن التاسع عشر عندما أرادت الدولة استخدام الحنفيات في مياه الشرب والوضوء، حيث وقف الحنابلة والشافعيّة ضد المشروع فلجأت السلطة إلى أصحاب المذهب الحنفيّ لتمريره، ومن يومها سميت (الحنفيّة) نسبة إلى المذهب الحنفيّ.
إذن إن الصراع الفكريّ جاء من خلال تفسير وتأويل طبيعة النص المقدس ذاته، كونه حمّال أوجه من جهة، ومن موقف الذين في قلوبهم زيغ الذين فسروا هذا النص وأولوه لمصالحهم ومصالح القوى الحاكمة التي يعملون في خدمتها من جهة ثانية. أما الضحيّة فهم الرعيّة، الذين لا حول لهم ولا قوة… الرعيّة التي كان ولم يزل وعيها مغيباً عن حقيقة هذا النص المقدس، وعن أهداف من قام بتفسيره وتأويله لهم من الذين في قلوبهم زيغ من مشايخ السلطان وتجار الدين. وبالتالي كانت الرعيّة في القرون الوسطي، والجماهير في تاريخنا المعاصر، ليسوا أكثر من حطب وقود لأيديولوجيا مفوّته حضاريّا، ولقوى اجتماعيّة تتجر بالدين، لازالت تشتغل على هذه الأيديولوجيا حتى اليوم خدمة لمصالح أنانيّة ضيقة. وإن كل ما جرى ويجري اليوم من حروب أهليّة وصراعات طائفيّة ومذهبيّة، وراءها قوى اجتماعيّة وسياسيّة لها مصالحها التي تريد تمريرها عبر الخطاب الدينيّ نفسه، مستغلة تلك التناقضات العميقة فيه التي أشرنا إليها أعلاه.
أما بالنسبة لمسألة الخلاص من المأزق الذي نحن فيه اليوم، أي الخلاص من أعشاش التخلف والفوات الحضاريّ والكراهية والحقد والصراعات الطائفيّة والمذهبيّة، فأعتقد أن الخلاص من كل أفخاخه لن يأتيّ بالنوايا الحسنة، ولا بالأمنيات أو الدعاء لله كي يخلصنا مما نحن فيه من مآسٍ، راحت تزداد علينا يوماً بعد يوم، بالرغم من تكاثر عدد المساجد في عالمنا العربيّ والصرف عليها مليارات الدولارات لتزيينها بالموزايك والصدف والأرابيسك وحتى بالذهب. ولن يأتي الخلاص أيضا من قبل القوى الحاكمة التي وظفت الدين لمصالحها الأنانيّة الضيقة، وتاجرت بالعلمانيّة والديمقراطيّة ودولة القانون. إن الخلاص بحاجة لقوى اجتماعيّة مؤمنة بوطنها ومصالحه، وبالتالي مصالح الجماهير المعذبة والمسحوقة والمغربة والمستلبة والمشيئة والمقموعة والخائفة والجائعة والمشردة.. إن الخلاص بحاجة أيضاً لثورة عقلانيَّة تنويريّة تؤمن بالإنسان ودوره في تقرير مصيره.
ربما يسأل الكثير اليوم من هي هذه القوى الاجتماعيّة المؤهلة لحمل المشروع النهضويّ التنويريّ في عالمنا العربي؟.. أقول: هي القوى التي ستظهر من أقبية الظلام والجهل والمعاناة والفقر والجوع والحرمان والغربة والتشيىء والاستلاب والمحاصرة في حركتها وفكرها.. وإن كل الظروف القاسية التي تعيشها شعوب دولنا الشموليّة في مضمونها وشكلانيّة علمانيتها وديمقراطيتها ستخلق بالضرورة القوى الاجتماعيّة القادرة على تحقيق الخلاص، وهذا الخلاص يتحقق لو وعت هذا القوى نفسها واستخدمت عقلانيتها استخداماً صحيحاً في العمل من أجل تحقيق مصالح الشعوب. وهذا هو الفرق في تحقيق الخلاص بين فكرة الإمام المنتظر لتحقيق لدى الشيعة، والأعور الدجال عند السنة، أو المسيح المخلص لدى المسيحيّة وحتى اليهوديّة. وبين اعتبار إن المخلص هنا هم هذه القوى المسحوقة من الشعب التي فقدت كل شيء إلا كرامتها وقدرتها على التغيير.
*كاتب وباحث من سوريّة
d.owaid333d@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
* – الفرق بين التاريخ والتاريخانيّة:
التاريخية: هو الاقرار بأن الإنسان والأشياء والفكر بعمومه والكون لها تاريخها وحركتها وتطورها وتبدلها، بغض النظر عن سلبها وإيجابها.
والتاريخانيّة: هي الاعتقاد بجوهر التاريخيّة مع تجاهل الجوانب المثالي فيها وخاصة (الدين) أي رصد المواقف الثابتة العيانيّة والعقلانيّة. أو بتعبير آخر: اعتبار أن مفردات التاريخ هي منجزات للإنسان، لأن الإنسان هو الفاعل الأول والأخير في التاريخ، فهو الذي ينتج الثقافة والمؤسسة، وكل ما يشكل الحياة. وبالتالي فإن التاريخانيّة هي الوعي بالتحول والتغيير وفهم الوجود من معطى التغيير، باعتبار أن الإنسان هو الكائن التاريخي الوحيد.





