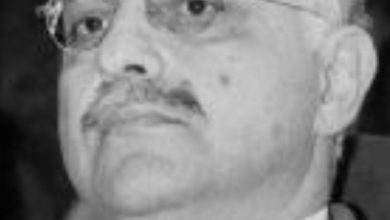الأنشطة الرّيعيّة.. ثمن عدم المساواة(سعيد عيسى)

بقلم الدكتور سعيد عيسى – الحوارنيوز
في كتابه “ثمن عدم المساواة((The Price of Inequality، يُقدّم الاقتصاديّ الحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغليتز، تحليلًا نقديًّا للسّبب وراء اتّساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. يُعَدُّ الكتاب لائحة اتّهامٍ ضدّ نظامٍ رأسماليٍّ يرى ستيغليتز أنّه انحرف عن مساره، ليس بسبب قوانين السّوق، بل بسبب ممارساتٍ مُتَعَمَّدَةٍ تخدم مصالح القلّة على حساب الأغلبيّة. في صلب هذا التّحليل، تقع الأنشطة الرّيعيّة (Rent-Seeking) كآليةٍ رئيسيّةٍ تفسّر كيف يكتسب الأغنياء ثرواتٍ هائلةً، ليست عن طريق خلق قيمةٍ جديدةٍ، بل من خلال الاستيلاء على قيمةٍ موجودةٍ بالفعل.
لفهم مفهوم الأنشطة الرّيعيّة، يجب أولاً التمييز بينها وبين الأرباح الرأسماليّة. الأرباح تأتي من الاستثمار المنتج والابتكار الذي يضيف قيمةً للاقتصاد، مثل بناء مصنعٍ جديدٍ، أو اختراع منتجٍ يسهّل حياة الناس. في المقابل، الرّيع هو الحصول على دخلٍ يفوق العائد الطّبيعيّ أو التّنافسيّ، دون إنتاج أيّ قيمةٍ إضافيّةٍ. أمّا الأنشطة الرّيعيّة، فهي الممارسات التي تسعى لتحصيل هذا الرّيع.
يشير ستيغليتز إلى أنّ هذه الأنشطة ليست مجرّد “استغلالٍ لثغراتٍ”، بل هي جزءٌ لا يتجزّأ من النّظام الاقتصاديّ والسياسيّ، حيث يسعى الأفراد والشّركات الأقوياء للتّلاعب بـ”قواعد اللعبة” لصالحهم.
لم يبتكر ستيغليتز مفهوم الأنشطة الرّيعية، بل ساهم في إعطائه زخمًا كبيرًا. تعود جذور هذا المفهوم إلى مجموعةٍ من الاقتصاديين الذين أثروا في “نظريّة الاختيار العام” (Public Choice Theory)، التي تدرس السّلوك السّياسيّ باستخدام أدوات التّحليل الاقتصاديّ. من أبرز هؤلاء:
- جوردون تالوك (Gordon Tullock) الذي يعتبر الأب الرّوحيّ للمفهوم، حيث أشار في عام 1967 إلى أنّ السّعي وراء الرّيع لا يقتصر على مجرّد إعادة توزيع الثّروة، بل يتسبب في “تكاليف اجتماعيّةٍ” حقيقيّةٍ. فالشّركات التي تنفق أموالًا على الضّغط السّياسيّ للحصول على امتيازاتٍ لا تضيف أيّ قيمةٍ للمجتمع، بل تهدر موارد ثمينة (مثل أجور المحامين، ومسؤولي الضغط) في صراعٍ صفريّ المكاسب.
- آن كروجر (Anne Krueger)، التي صاغت مصطلح “المجتمع الباحث عن الرّيع” 1974 (The Rent-Seeking Society) في ورقةٍ بحثيّةٍ شهيرةٍ. درست كروجر الاقتصادات النّامية التي تعاني من تنظيماتٍ حكوميّةٍ صارمةٍ، ووجدت أنّ هذه التّنظيمات تخلق فرصًا واسعةً للأنشطة الرّيعية، ممّا يعيق نموّها الاقتصاديّ.
- مانكور أولسون (Mancur Olson)، الذي قدّم في كتابه “منطق العمل الجماعيّ” تفسيرًا أساسيًّا لسبب تفشّي الأنشطة الرّيعية. يجادل أولسون بأنّ الجماعات الصّغيرة ذات المصالح المتركّزة (مثل شركات أو نقابات معيّنة) يسهل عليها تنظيم نفسها والضّغط على الحكومة للحصول على امتيازاتٍ. في المقابل، فإنّ الجماعات الكبيرة ذات المصالح الموزّعة (مثل المستهلكين أو دافعي الضّرائب) تواجه صعوبةً في التّنظيم. هذا التفاوت في القدرة على التّنظيم يُفسّر لماذا غالبًا ما تُهزم الأغلبيّة من قبل الأقلّيّة في عملية صنع السّياسات.
يحدّد جوزيف ستيغليتز في كتابه “ثمن عدم المساواة” مجموعةً من الآليات التي تستخدم لتحقيق الرّيع، مقدماً أمثلةً ملموسةً تظهر كيفية عمل هذه الآليات على أرض الواقع. حيث يعدّ الاحتكار أو السّيطرة على جزءٍ كبيرٍ من السّوق أحد أكثر أشكال الأنشطة الريعيّة وضوحاً. فعندما تتمكّن شركة ما من القضاء على منافسيها، تكتسب القدرة على فرض أسعارٍ أعلى بكثيرٍ من التّكلفة الهامشيّة للإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرباح الإضافية لا تنبع من كفاءةٍ أعلى أو ابتكارٍ حقيقيٍّ، بل هي ببساطةٍ ثمرةٌ لغياب المنافسة.
كما يلفت ستيغليتز إلى أنّ الموارد الطبيعيّة، كالنّفط والغاز، تشكّل مصدراً رئيسيّاً آخر للرّيع. فعندما تمنح الحكومات شركاتٍ خاصةً حقوق التّنقيب والاستخراج بأسعارٍ أقلّ بكثيرٍ من قيمتها السّوقيّة الحقيقيّة، تحصل هذه الشركات على أرباحٍ طائلةٍ دون جهد يذكر. ويؤكد ستيغليتز على أن هذه الموارد هي في الأصل ملك للشعب، وبالتالي فإن عوائدها يجب أن تعود إلى المجتمع بأسره، وليس إلى حفنة من الأفراد.
ولا يغفل ستيغليتز عن دور القطاع المالي كبيئةٍ خصبةٍ للأنشطة الرّيعية، حيث يخصّص جزءاً كبيراً من كتابه لانتقاد هذا القطاع. ويوضح أنّ جزءاً كبيراً من أرباح وول ستريت قبل الأزمة الماليّة العالميّة لم يكن ناتجاً عن استثماراتٍ حقيقيّةٍ في الاقتصاد المنتج، بل جاء من أنشطة مضاربةٍ معقّدةٍ وغير شفّافةٍ. وقد سمحت المعلومات غير المتماثلة وغياب التّنظيم الكافي للمصرفيين بجني أرباحٍ هائلةٍ، بينما تم تحميل المخاطر والعواقب على عاتق عامّة الناس ودافعي الضّرائب.
وتشكّل الإعانات الحكوميّة وعمليّات الإنقاذ شكلاً آخر من أشكال الرّيع. فالإعفاءات الضريبيّة والمنح الحكوميّة وعمليّات إنقاذ الشّركات الفاشلة كثيراً ما تبرّر بحجّة الحفاظ على الوظائف أو استقرار الاقتصاد. لكن ستيغليتز يرى أنّ هذه الإجراءات غالباً ما تؤدّي في النهاية إلى خصخصة الأرباح وتأميم الخسائر، حيث تذهب المكاسب إلى القطاع الخاص بينما تتحمّل الدّولة والمجتمع تبعات الفشل.
كما يسلّط ستيغليتز الضوء على الاقتصاد الرّقميّ كمجالٍ جديدٍ للأنشطة الريعيّة، حيث تعدّ شركات التّكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيسبوك أمثلةً بارزةً على ذلك. هذه الشركات تتّهم بإنشاء احتكاراتٍ طبيعيّةٍ، ليس فقط من خلال الابتكار التّقنيّ، بل أيضاً عبر الاستحواذ على المنافسين الأصغر، واستخدام البيانات الخاصّة للمستخدمين بطرقٍ تمنع ظهور أيّ منافسةٍ حقيقيّةٍ في السّوق.
يعدّ الاحتكار أو السّيطرة على جزءٍ كبيرٍ من السّوق من أوضح أشكال الأنشطة الرّيعيّة؛ فعندما تتمكّن شركةٌ من القضاء على منافسيها تكتسب القدرة على فرض أسعار ٍتفوق التّكلفة الهامشيّة للإنتاج، وهذه الأرباح الإضافيّة لا تنبع من كفاءةٍ أعلى أو ابتكارٍ حقيقيٍّ بل هي ثمرة غياب المنافسة. ويلفت ستيغليتز إلى أن الموارد الطّبيعيّة كالنّفط والغاز تشكّل مصدرًا رئيسيًّا آخر للرّيع؛ فعند منح الحكومات شركاتٍ خاصّةٍ حقوق التّنقيب والاستخراج بأسعارٍ أقلّ من قيمتها السّوقية تحصل هذه الشّركات على أرباحٍ طائلةٍ دون جهدٍ يذكر، ويؤكّد أنّ هذه الموارد ملك للشّعب وعوائدها يجب أن تعود إلى المجتمع بأسره. ولا يغفل دور القطاع الماليّ كبيئةٍ خصبةٍ للأنشطة الرّيعيّة، إذ جاءت أجزاءٌ كبيرةٌ من أرباح وول ستريت قبل الأزمة من مضارباتٍ معقّدةٍ وغير شفّافةٍ سمحت بجني أرباحٍ هائلةٍ بينما تحمّل الجمهور المخاطر والتّبعات، كما تشكّل الإعانات الحكوميّة وعمليّات الإنقاذ شكلا آخر للرّيع، حيث تؤدّي الإعفاءات والمنح وإنقاذ الشّركات الفاشلة غالبًا إلى خصخصة الأرباح وتأميم الخسائر. وأخيرًا يسلط الضوء على الاقتصاد الرّقميّ كميدانٍ جديدٍ للرّيع، حيث تتّهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيسبوك بخلق احتكاراتٍ طبيعيّةٍ عبر الابتكار، الاستحواذ على المنافسين الأصغر، واستخدام بيانات المستخدمين بطرقٍ تمنع ظهور منافسةٍ حقيقيّةٍ في السّوق.
في نهاية المطاف، يقدّم ستيغليتز رؤيةً حول كيفيّة مواجهة هذه المشكلة. يرى أنّ الحلّ لا يكمن في التّخلّي عن الرأسماليّة، بل في إصلاحها. يطالب بـ”إعادة كتابة قواعد اللعبة” لضمان أنّ النّظام الاقتصاديّ يعمل لصالح الجميع، وليس فقط الأقوياء.
تشمل الحلول المقترحة:
- تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بصرامةٍ لمنع الشّركات من استغلال قوّتها السّوقية.
- إصلاح النّظام الضّريبيّ لفرض ضرائب أعلى على الأرباح النّاتجة عن الأنشطة الرّيعيّة، مع خفض الضرائب على الأنشطة الإنتاجيّة.
- زيادة الشّفافية في القطاع الماليّ وفرض قيودٍ أكثر صرامةً على الأنشطة المضاربة.
- الحدّ من النّفوذ السّياسيّ للمال من خلال إصلاح تمويل الحملات الانتخابيّة.
في الختام، يتجاوز مفهوم الأنشطة الرّيعيّة كونه مجرّد فكرةٍ اقتصاديّةٍ، ليصبح عدسةً لتحليل العديد من المشكلات الاجتماعيّة والسّياسيّة. فكما أشار ستيغليتز، الأنشطة الرّيعية هي السّبب الجذريّ وراء عدم المساواة المتزايد في العصر الحديث. وقد أثبت روّاد مثل تالوك، وكروجر، وأولسون أنّ هذه الأنشطة ليست ظواهر عشوائيّةٍ، بل هي نتيجةٌ منطقيّةٌ لمؤسّساتٍ اقتصاديّةٍ وسياسيّةٍ تسمح بتفشّيها. إنّ مكافحة الأنشطة الرّيعية تتطلّب إصلاحاتٍ شاملةً لا تقتصر على السّياسات الاقتصاديّة، بل تمتدّ لتشمل إعادة هيكلة
القواعد التي تحكم العلاقة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنيّ، وذلك بهدف بناء نظامٍ اقتصاديٍّ أكثر عدلًا وكفاءةً.