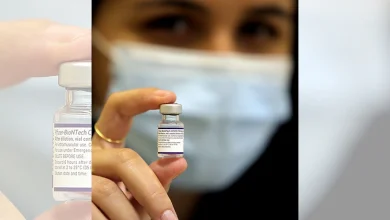منوعات
العلامة الخطيب يجري عملية قسطرة قلبية ناجحة في مستشفى الزهراء

الحوارنيوز – منوعات
أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم عملية قسطرة للقلب في مستشفى الزهراء على يد الدكتور علي السيد وبإشراف رئيس المستشفى البروفسور يوسف فارس ،تبيّن من خلالها إنسداد أحد الشرايين فجرت معالجته بنجاح.
وسيخضع العلامة الخطيب لعملية مراقبة تقليدية في المستشفى لعدة أيام ،وقد تلقى إتصالات من عدد من الشخصيات هنأت بسلامته.